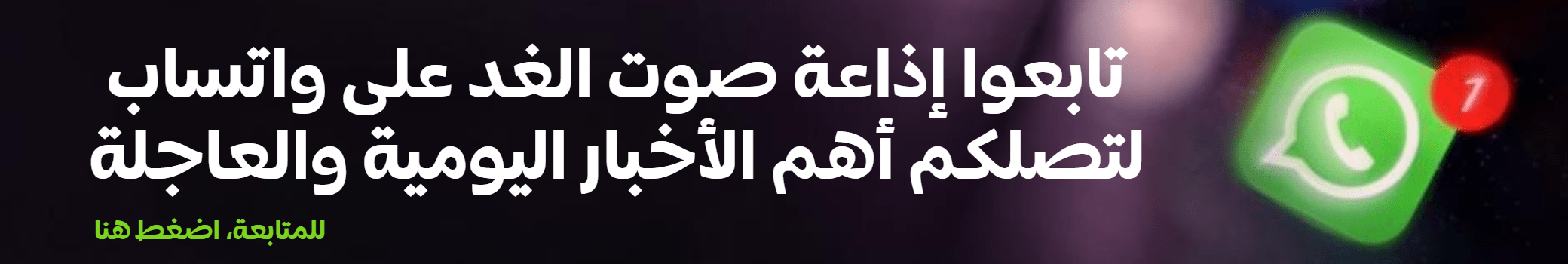موطني الجَلالُ وَالجَمالُ
السَناءُ وَالبَهاءُ في رُباك
وَالحَياةُ وَالنَجاةُ
وَالهَناءُ وَالرَجاءُ في هَواك
ربما يعرف كل من نطق العربية ذلك النشيد، الذي يحرّك الوجدان ويلامس شغاف القلب، تتنهد الصدور شوقاً وتطلعاً إلى ذاك الوطن الذي نريد أن نراه سالماً منعماً وغانماً مكرماً.. نتساءل أي قلب جاد بهذا الفيض من الشعور العميق لما نحب، والانتماء الصادق للأرض والسماء وشعب نألفه فنسميه الوطن.
إبراهيم بن عبد الفتاح طوقان، شاعر فلسطين أو الشاعر الثائر، الذي وُلد في لحظة فارقة في تاريخ فلسطين، إذ سيساهم خلال سنينه الـ36 في بلورة الروح الوطنية الفلسطينية، بل ستتجاوز حدود فلسطين مع الزمن واستمرار حرب التحرير الفلسطينية لأكثر من 75 عاماً، فسنجد العراق تقتبس كلمات موطني ليصبح نشيدها القومي، ولتكن أغانيه معبرة عن الشارع أكثر من قصور السلاطين.
فوق شجر النارنج
إبراهيم طوقان وُلد عام 1905 في نابلس، ليكون الابن الثاني لأسرة ميسورة الحال، فأخوه الكبير أحمد طوقان هو رئيس وزراء الأردن عام 1970، أما أخته فهي نار وعلم فدوى طوقان، والتي ساعدها إبراهيم في إبراز موهبتها الشعرية.
اهتمت أسرته بالعلم فأرسلت أخاه للدراسة إلى المدرسة الرشادية الغربية في نابلس، ثم إلى القدس، ومنها إلى بيروت، وعلى نفس الطريق يسير حذو القذة بالقذة، وهيهات أن تتساوى النتائج. إذ تلقى في المدرسة الرشادية على يدي أساتذة متأثرين بمدرسة البعث والإحياء التي وُلدت في القاهرة على يد رب السيف والقلم محمود سامي البارودي، ورفع لواءها أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، وقد كان جل أساتذته في مدرسة الرشادية تتلمذوا في الأزهر، كالشيخ إبراهيم أبو الهدى الخماش الذي سيكون له بالغ الأثر في إذكاء الروح العربية في نفس إبراهيم طوقان، وهو نفسه سينخرط في الثورة العربية 1921م، وكذا كان أستاذه في تلك المدرسة الشيخ فهمي أفندي هاشم، قاضي قضاة شرقي الأردن.
تحكي فدوى طوقان في كتابها، الذي عنونته بـ”أخي إبراهيم” 1946م، والذي أُعيد نشره في صدر كتاب الأعمال الشعرية الكاملة لإبراهيم عام 2002، عن بداية قرض الأهازيج والتغني بها: “كان إبراهيم لعوباً إلى حدٍّ بعيد، لا يقتصد إذا أخذ بسبب من أسباب العبث واللعب، وكأنما كانت نفسه تضيق بإهابه فلا يهدأ، ولا يستقر. وهو في أحيان كثيرة على خلاف مع جدته لأمه، رحمها الله، إذ كان على وفاق مع طبيعته المرحة اللعوب، كان يعرف نزق جدته وضيقها بالضجة والحركة، فلا يألو جهداً في معابثتها واستفزازها، وذلك لكي تزجره وتنتهره برطانتها التركية التي كانت تخالطها من هنا وهناك كلمات عربية، لا تستقيم لها مخارج بعض حروفها، فتأتي ملتوية عوجاء، تبعث إبراهيم على الضحك، ولقد تهمّ الجدة باللحاق به، فيفر منها.. ويتسلق إحدى شجرات النارنج التي تمتلئ بها ساحة الدار، وهناك يأخذ مكانه بين الفروع الغليظة الصلبة، وينتهي الأمر بينهما عند هذا الحد. ثم يشرع، وهو في مقعده ذلك من الشجرة، يترنّم بالأهازيج الشعبية التي كانت تروق وتلذه كثيراً”.
كفلسطين التي أصابها مرض مزمن عانى أيضاً طوقان منذ نعومة أظافره بالأمراض، ما جعل له خصوصية في المنزل وارتباط قوي بينه وبين أبويه وعناية فائقة. أرسل إلى القدس ليستأنف تعليمه في مدرسة المطران، وهناك تتلمذ على يد نخلة زريق أحد المنتمين للمدرسة “اليازجية” وهو أستاذ أخيه بالكلية الإنجليزية، حيث سيدرس كل منتخبات الأديب زريق ويحفظها، ثم حاول قرض الشعر بدون هدى ولا سراج يضيء طريق القريحة.
انتقل أخوه إلى الجامعة الأمريكية ببيروت وينقل له ما عرفه عن العروض موسيقى الشعر ووزنه، بعدها يستأنف إبراهيم طوقان الدراسة ببيروت، وفيها ستتفتح زهر الأديب وتينع. ويقع في الحب فيخفق فيستحيل لوعة الوجد شعراً غزلياً وأدباً رفيعاً.
أنهى تعليمه في بيروت 1929م، عاد إلى نابلس، وبدا له أن يستعد للسفر للعمل كصحفي بالقاهرة، وبعد زيارتها مع والده رفضت والدته أن ينتقل إليها فامتثل لرأيها براً، وامتهن التعليم في مدرسة النجاح بنابلس مع كرهه لوظيفة التعليم، ثم بعدها يأتي له عرض للتدريس في بيروت ليذهب لمدة عام قبل أن يعود إلى نابلس مرة أخرى، وهكذا ذهاباً واياباً ما ترك فلسطين إلا عاد إليها بقلب شجرة زيتون غرسة عميقاً في أرض نابلس وبروح برتقال يافاوي لم يفقد رائحته الزكية ولو طال عليه العمر.
بعمر 32 عاماً في سنة 1937 تعرّف إبراهيم بـ”سامية عبد الهادي” من إحدى أسر نابلس، فاتجه إليها قلبه، وهناك استقر؟ فأصبحت شريكة حياته، وعاش هانئاً في بيته، سعيداً بعاطفة جديدة مقدسة هي عاطفة الأبوة، إذ رُزق “جعفر” و”عريب”.
جنية الشعر
تعرّض طوقان لوعكة صحية أثناء دراسته في بيروت عام 1924 أجبرته للعودة إلى نابلس لشهور، وعنيت به ممرضات، فقرض فيهن قصيدة “ملائكة الرحمة”، وهي التي ستعلن عن ولادته الشعرية عندما نشرها في مجلة المعرض البيروتية، لتنقلها مجلة “سركيس” اللبنانية ثم “التمدن” الذي أسسها حبيب أسطفان وجبران مسوح في الأرجنتين.
حاول بعدها التكلف في قصيدة، وما إن وضع المولد إذ به يتخطفه إلى أخيه أحمد وصديقه سعيد تقي الدين، اللذان لهما ذائقة شعرية فيمزقانها أمام عينيه، ويقولان له إنها فيها تكلف، لا تستكثر من الشعر فجنية الشعر وإن تأخرت على قلب شاعر فستجود بما هو مثل أو أكبر من ملائكة الرحمة، وقد كان..
سيمر بعدها بقصة عاطفية مع فتاة فلسطينية كانت في الجامعة ليقرض شعر الغزل ويبرع فيه:
يا زَهرَةَ الوادي أَتيتُ بِزَهرة
لَكِ مِن رُبى لُبنان فاحَ شَذاها
وَالزَهر أَبهى مَنظَراً مَعَ أُمه
فَنقلتها مَعها فَزادَ بهاها

ومتأثراً بشوقي، وبجيل القومية العربية في لبنان، سينضج شعره الوطني وفيه هوية فلسطين كاملة، يجاري شوقي في قدحه الاحتلال الفرنسي بعد قصفه لدمشق، حيث قال شوقي “سلام من صبا بردى أرق* ودمع لا يكفكف يا دمشق… إلى قوله يفصلها إلى الدنيا بريد * ويجملها إلى الآفاق برق”، فيقول طوقان
لِفَرَنسا ما تَشتَهي لِفَرَنسا
ما تَمنَى فَمَوعد الثَأر دان
أَسَدٌ فَوقَ ضامر عَرَبي
شاهر لِلوَغى حساماً يَماني
أَرهَفتهُ المَنون ثُمَ أَنامت
ـــه لِيَوم محجّل أَرونان
صَفحتاه عَقيقتان مِن البَرق
وَفي مضربيه صاعِقَتان
لفظ النار والدمار: الشخصية الشعرية
لإبراهيم طوقان حضور كبير في القصيدة الوطنية، بل هو ما اشتهر بها، في قصيدة موطني الجلال والجمال، إلا أن ذيوع صيته كان بقصائده عن ثورة البراق 1929م، عندما أبن الشهداء فؤاد حجازي ومحمد جمجوم وعطا الزير في قصيدة “الثلاثاء الحمراء”، وفي قصيدة “الشهيد” عندما نعاهم ثانية في ذكراهم الرابعة.
وقرض قصيدة الفدائي “صامت لو تكلما” التي غنيت ولحنت في شارة مسلسل التغريبة الشهير، وكذا كانت فلسطين حاضرة بآفات الزمن الذي تغلغل في أواصرها، مثل سماسرة بيع البلاد، والسرطان المستشري فيها الصهيونية والانتداب البريطاني الذي أسماهم بالعدوين في شعرهما، مستنهضاً العربي النائم في السبات.
نقلت فدوى طوقان أن إبراهيم عندما كان يعلم في الجامعة الأمريكية ببيروت التقى بلويس نيكل البوهيمي، وهو مستشرق تخصص في الغزل العربي، فكان يتنقل بين عواصم الشرق والغرب، باحثاً في مكاتبها الكبرى عن الكتب المتعلقة بموضوعه، وكان من نتيجة ذلك أن ترجم إلى اللغة الإنجليزية كتاب “طوق الحمامة” لابن حزم الأندلسي، وقد تعرّف إبراهيم بالدكتور نيكل عن طريق صديقه الأستاذ أنيس فريحة، وكان هذا المستشرق، حين تعرف بإبراهيم، قد بدأ بتصحيح كتاب “الزهرة” لابن داود الأصفهاني، وتعليق حواشيه وتنظيم فهارسه. فلما رأى مدى اطلاع إبراهيم على الشعر القديم دعاه إلى العمل معه وأشركه في تصحيح الكتاب وطبعه، وباشروا العمل معاً في اليوم الثاني للمقابلة الأولى، وفي بضعة شهور أنجزوا عملهم فيه، حيث طُبع الكتاب سنة 1932، ويقول الدكتور نيكل “أقمنا حفلة (الزهروية) في مطعم نجار، ونظم إبراهيم قصيدته “غادة أشبيلية”، وكانت تلك الأيام من أسعد أيامه وأيامي”.
له حس فكاهي فقد عارض شوقي في مقولته “قف للمعلم وفه التبجيلا* كاد المعلم أن يكون رسولا”، بقوله:
اقْعُدْ فَدَيْتُكَ هَلْ يَكُونُ مُبَجَّلاً
مَنْ كَانِ لِلْنَشْءِ الصِّغَارِ خَلِيلا
لَوْ جَرَّبَ التَّعْلِيمَ شَوْقِي سَاعَةً
لَقَضَى الْحَيَاةَ شَقَاوَةً وَخُمُولا
يَا مَنْ يُرِيدُ الانْتِحَارَ وَجَدْتـهُ
إِنَّ الْمُعَلِّمَ لاَ يَعِيشُ طَويلا
ديوان له لم يره
انتخب إبراهيم وانتقى 77 قصيدة من أشعاره لكي تطبع في ديوان، لكنه لم ير ذلك الوليد، فقد طبع أول مرة بعد وفاته بأكثر من 14 عاماً 1955، عن دار الشرق الجديد في بيروت، وفي 1975 أصدرت دار القدس في بيروت طبعة جديدة لديوان الشاعر اعتبرت نقلة جديدة إذ ضمت الأشعار التي احتوتها طبعة دار الشرق، وأضافت إليها (36) قصيدة جديدة، دون أن تذكر مصادرها، ورتبت القصائد فيها بترتيب زمني.
ستون عاماً مرت على وفاته، حتى صدرت طبعة تضم كل أعماله الشعرية من إعداد ماجد الحكواتي عام 2002، إذ بلغت قصائده 158 قصيدة بعدد أبيات 2530 بيتاً، من إصدار مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، فيها قصائد اشترك في قرضها مع شعراء عرب من العراق وسوريا حافظ جميل ووجيه بارودي على الترتيب.
كتب إبراهيم طوقان المقالة والنقد الأدبي أيضاً، كمقالة “جبابرة التأليف بين الأمس واليوم” وهي مقالة نشرها في مجلة الأماني البيروتية، وقد وقع إبراهيم تلك المقالة بتوقيع (الأحنف) في العدد 30 سنة 1939 وأدب المنادمة عند أبي نواس في العدد 14 ومأساة ديك الجن الحمصي في العدد 5 سنة 1941 ومن مقالاته التي كتبها للإذاعة: مؤامرة على الفصحى، عقد اللؤلؤ، وفاء مزعوم، أشواق الحجاز.
الردى منه خائف: العراق الفصل الأخير
عمل طوقان في إذاعة القدس، التي أسسها الاحتلال البريطاني عام 1936م، قدم خلالها برامج عربية أصيلة كان يعدها بيد غازل سجاد، وبعين حرفي النحاس، وبقلب ناقد متشكك، وأديب أريب، فقد كان يفكك قصائده متى ما لم تعجبه، فينقض غزلها بيتاً بيتاً حتى ينقض عراها، ولم يبق إلا الحرف، ولو شاء لحطمه.
كان يمرر الرسائل الباطنية عبر المذياع، مستحثاً الروح العربية النائمة والغارقة في الاستخفاف بمصير النعاج الذي بيت لها بليل، وما أطول ليل فلسطين والعرب! وانتهى الأمر به مطروداً من الإذاعة بعد أن حرضت عليه الجماعات الصهيونية عندما قدح في رواية أوفى الشعراء “السموأل” ذلك اليهودي الذي نسج عنه رداء من كذب فضرب بوفائه المثل وهو على الضد.
فقرر أن يهاجر إلى العراق وألا يعود إلى فلسطين ما حيا، ولكنها اللعنة كما قالها قباني ” وعدتك ألا أعود اشتيقاً وعدت” جسده المنهك كفلسطين التي ينخرها سرطان الصهيونية والانتداب، جسده الأرض اشتاق إلى كله في نابلس، فعاد بعد أن نخر المرض أمعاءه، بجسم هزيل وبقلب متعلق بالقرآن كما وصفته أخته فدوى، ودعت روحه أرض فلسطين والتحم الجسد بها مايو/آيار 1941م، ثم بعثت كالعنقاء من تحت الرماد روح فلسطين الكاملة، تارة تبلغ السماء في شعره، وتارة أخرى في روح مقاوم خاف الردى منه إذ هو بالباب واقف، يلفظ ناراً ودماً في غزة، وربما في الضفة.