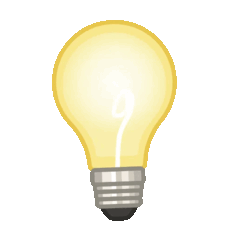الاسم كمعركة وجود: مقاومة فلسطينية لمحو الهوية على خرائط الاحتلال
د. بدر زماعرة : يُشكّل الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين نموذجًا مركّبًا من الاحتلال العسكري والاستعمار الإحلالي، القائم على سياسات ممنهجة لمحو الذاكرة الجغرافية والهوية الثقافية للسكان الأصليين. فالمسألة لا تقتصر على السيطرة على الأرض، بل تمتد إلى إعادة تشكيل المكان وإعادة تسميته بما يخدم سردية المستعمِر، في محاولة لإلغاء حضور الشعب الفلسطيني من التاريخ والجغرافيا في آنٍ واحد.
وقد عبّرت هذه السياسات عن نفسها عبر منظومة الاستيطان التي تُعدّ، وفقًا للمادة (49/6) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، جريمة حرب تتمثل في نقل دولة الاحتلال جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة.
فالاستيطان هو الذراع التنفيذي للمشروع الاستعماري، بينما تُشكّل إعادة التسمية وتغيير المعالم والخرائط أداته الرمزية في طمس الهوية وفرض واقع جديد يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
إن سياسة “إحلال الاسم” ليست تفصيلًا لغويًا، بل فعلًا استعماريًا ممنهجًا يسعى إلى نزع الشرعية التاريخية والقانونية عن المكان الفلسطيني، وتحويل الوجود المادي والرمزي للفلسطينيين إلى غيابٍ مُخطّط.
وهكذا يتكامل الاستيطان كفعل مادي مع سياسة المحو كفعل لغوي وثقافي، في ما يمكن تسميته بـ”الاستعمار عبر اللغة”، حيث يُستبدل الاسم ليُستبدل المعنى، وتُطمس الذاكرة لتُمحى الجغرافيا.
لا توجد حرب يخوضها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بلا عنوان، ولا معركة تُشنّ في الفراغ. فكل معركة تبدأ من اللغة، ومن الاسم، ومن الرواية التي يُراد لها أن تُصبح “الحقيقة” في عيون العالم. ولهذا، فإن محاولات استبدال الأسماء الفلسطينية الأصيلة بمسميات استيطانية ليست عابرة أو محايدة؛ بل هي حرب على الذاكرة والجغرافيا والهوية، تُشنّ بتدرّج وهدوء، لكنها تترك أثرًا أعمق من الجدار والحاجز والبوابة.
في كل يوم نسمع: يتسهار، شافي شومرون، دولف، حلميش، عطيرت، ألون موريه، عتنائيل، معاليه أدوميم، كرمي تسور… لكن خلف كل اسم عبري، هناك قرية فلسطينية لها جذورها الممتدة في الأرض قبل قيام المشروع الاستيطاني بقرون.
الاسم في الجغرافيا ليس مجرد كلمة؛ إنه وثيقة ملكية ثقافية وتاريخية. على سبيل المثال، حين يُسمّى الجبل “جبل الريسان” ثم يعاد تسميته إلى “سديه افرايم”، فهذا ليس تصحيحًا لغويًا، بل محاولة لطمس صلة الفلسطيني بالمكان، وتحويل موقع فلسطيني إلى حقيقة جديدة تُفرض على الخرائط، وعلى الوعي الجمعي، وعلى الخيال الدولي. يعرف الاحتلال جيدًا أنّ من يمتلك الاسم يمتلك الخريطة، ومن يمتلك الخريطة يمتلك السردية، ومن يمتلك السردية يطمح لامتلاك الأرض، وهكذا تتحول التسمية الاستيطانية إلى محاولة لخلق أرض دون صاحب وجغرافيا بلا جذور.
وهذا الفعل لا يقف عند حدود اللغة، بل يندرج قانونيًا ضمن تغيير معالم الأرض المحتلة المحظور وفق المادة (47) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنص على أن الاحتلال لا يمنح سلطة شرعية لتغيير الطابع القانوني أو الجغرافي للأرض المحتلة.
كما يتعارض مع المادة (43) من لائحة لاهاي لعام 1907 التي تُلزم سلطة الاحتلال باحترام القوانين والنظم القائمة في البلد المحتل. والاسم هنا أحد هذه القوانين الرمزية التي تعبّر عن هوية الأرض وسيادتها الثقافية.
الاستيطان لا يبنى على الفراغ، بل على أرض لها تاريخ وسكان وجذور ضاربة في عمق المكان، وهذه بعض الأمثلة التي تكشف خريطة الطمس المستمر: فمستعمرة “دولِف” تقام فوق أراضي الجانية ورأس كركر ودير إبزيع، و”حلميش” على أراضي النبي صالح ودير نظام، و”يتسهار” فوق بورين ومادما وعصيرة القبلية، و”شافي شومرون” وسط أراضي دير شرف، و”أريئيل” التي تتمدد فوق سلفيت وبروقين ومردا، و”معاليه أدوميم” على أراضي أبو ديس والعيزرية والسواحرة الشرقية، و”ألون موريه” فوق أراضي دير الحطب وسالم وعزموط، و”سوسيا” فوق أراضي يطا ومسافر يطا.
وبالتالي، فإن هذه التسميات ليست أسماء استيطانية فحسب، بل هي جزء من خريطة استعمارية تهدف إلى طرد الاسم الفلسطيني من الوعي قبل أن تطرد أهله من الأرض. وهي تُخالف بوضوح المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة التي توجب احترام عادات السكان وتقاليدهم وثقافتهم. فالاسم جزء من هذا التراث الثقافي الذي يحظر القانون الدولي الانساني المساس به أو تبديله.
يعمل الاحتلال على إعادة تشكيل الخرائط والوعي من خلال فرض أسماء جديدة على المدن والقرى الفلسطينية، محاولاً طمس التاريخ والهوية الثقافية وتحويل الأرض الفلسطينية إلى واقع جديد على الورق وفي الوعي العام. تبدأ هذه العملية بالاعتماد على الخرائط الرقمية الحديثة، حيث تُظهر شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Google Maps وWaze، إضافة إلى تطبيقات السياحة، الاسم العبري كمسمى “رسمي”، بينما يدفن الاسم الفلسطيني في الهامش أو يحذف كليًا. وهذا يشكل شكلاً من أشكال “المحو الرقمي” الذي يوازي “التهويد الميداني”، ويخالف المادة (53) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، التي تحظر أي عمل عدائي يستهدف الممتلكات الثقافية والروحية للشعوب.
لا يقتصر الأمر على العالم الرقمي، بل يمتد إلى الميدان أيضًا، حيث تُرفع على الطرق الالتفافية ومداخل المدن والقرى لافتات ضخمة بالأسماء العبرية، بينما يُخفى الاسم العربي أو يُكتب بخط أصغر، في مشهد يعكس تمييزًا ثقافيًا محرّمًا بموجب المادة (5) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965. ويتابع الاحتلال تعزيز هذه السيطرة عبر الخطاب الإعلامي الدولي، حيث تتبنى وسائل الإعلام الأجنبية الاسم العبري حصريًا في تغطياتها، فتكتب مثلًا “Clashes near Yitzhar”، وكأن بورين لم تكن يومًا على الخريطة، مما يحول اللغة إلى أداة استعمارية لإعادة تعريف الجغرافيا وإلغاء الذاكرة الفلسطينية.
كما تمتد أدوات الاحتلال لتشمل الرواية السياحية والتاريخية، إذ تُقدَّم المواقع الفلسطينية على أنها “مواقع توراتية”، بينما تُمحى القصص الأصلية لأهلها، في انتهاك واضح لاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية، التي تحظر استخدام أو تحوير المواقع التراثية لأغراض سياسية أو أيديولوجية. بهذا الأسلوب المتكامل، يتحول الاسم الجديد إلى أداة استعمارية تعمل على طمس الهوية الفلسطينية في كل بعد: الرقمي والميداني والإعلامي والتاريخي، قبل أن تطال الأرض نفسها وأهلها.
التسمية ليست كلمة فقط، بل فعل مقاومة وحق قانوني لا يمكن تجاوزه. من يقول “بورين” بدلاً من “يتسهار” يمارس مقاومة لغوية، ومن يكتب “رأس كركر” بدلاً من “دولِف” يدافع عن الذاكرة، ومن ينشر خريطة تحمل “دير الحطب” و”عزموط” بدل “ألون موريه” يشارك في معركة الهوية الفلسطينية. هذه المقاومة ليست رمزية فقط، بل هي ممارسة واقعية لحقوق مكفولة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
فالمادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 تضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها، بما في ذلك حقها في الحفاظ على ثقافتها وتاريخها وجغرافيتها. كما تؤكد المادة (27) من ذات العهد حق الجماعات في التمتع بثقافتها ولغتها ودينها دون تدخل أو طمس. ومن ثم، فإن التمسك بالأسماء الفلسطينية هو ممارسة عملية لحق تقرير المصير الثقافي واللغوي.
إضافةً إلى ذلك، تنص المادة (4) من اتفاقية اليونسكو لعام 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي على إلزام الدول، بما فيها قوة الاحتلال، بحماية التراث الإنساني القائم في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، لا استبداله أو محوه. بهذا، يصبح الدفاع عن الأسماء الفلسطينية جزءًا من حماية التراث والهوية الفلسطينية في آن واحد.
وفي خضم معركة الأسماء والهوية، فإن المكان لا ينسى، ولا يغيّر اسمه. ومهما حاول الاحتلال أن يفرض على الجغرافيا أسماء لا تشبهها، ستبقى الأرض تنادي بأسمائها الأولى: بورين، الجانية، دير نظام، أبو ديس، سلواد، رأس كركر، فصايل، العيزرية، يطا، عورتا… هذه الأسماء ليست حروفًا على الخرائط، بل ذاكرة حيّة وهوية متجذّرة في وجدان هذا الشعب، تُشبه أهلها وتاريخها، ولا تستبدل بقرار سياسي أو خريطة مُلفّقة.
فحين يُصر الفلسطيني على نطق أسماء الأماكن، يتحول هذا النطق إلى فعل مقاومة حيّة، فالمكان يقاوم بالتسمية كما يقاوم بالحجر. نحن إذن أمام معركة هوية شاملة، تتجاوز حدود الأرض لتشمل اللغة والذاكرة والانتماء. فطمس الاسم لا يعد إجراءً إداريًا عاديًا، بل جريمة استعمارية موثقة في القانون الدولي، تُجرّمها اتفاقيات جنيف ولاهاي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لأنها تمثل اعتداءً على حق الشعوب في الحفاظ على تراثها الثقافي وذاكرتها الجمعية. إن الدفاع عن أسماء القرى والمدن والبلدات الفلسطينية هو دفاع عن الوجود ذاته، فحين نتمسك بهذه الأسماء الحقيقية، نؤكد أن الهوية لا تُمحى، وأن الذاكرة أقوى من الجدار، وأعمق من الخرائط.
لذلك، نحن مسؤولون أمام حرب المسميات هذه، كمجتمع، حقوقيين، إعلاميين، مؤسسات، وباحثين، في الدفاع عن الهوية والذاكرة الفلسطينية. يتطلب ذلك ما يلي: استخدام الأسماء الفلسطينية في كل منشور وخبر وتقرير رسمي، وتصحيح المسمى عند سماعه بالاسم الاستيطاني، وتعليم أبنائنا الخرائط الأصلية للقرى والجبال والعيون، وتوثيق الأسماء التاريخية في سجل وطني رقمي مفتوح. كما يشمل واجبنا إنتاج خرائط فلسطينية بديلة تُبرز الهوية الأصلية للأرض، ورفض التعامل مع الأسماء العبرية كأنها “رسمية”، لأنها في جوهرها أداة استيطان لغوي تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
تحليل وتفاصيل إضافية
يكشف مقال الدكتور بدر زماعرة عمق الاستراتيجية الإسرائيلية في محو الهوية الفلسطينية من خلال تغيير الأسماء والمعالم، مؤكدًا أن ‘الاسم كمعركة وجود’ هو محور أساسي في الصراع. يحلل المقال كيف أن هذه السياسة تتجاوز مجرد تغيير لغوي لتصبح أداة استعمارية شاملة، تستهدف الذاكرة والجغرافيا والتاريخ. يوضح الكاتب كيف تتكامل هذه الاستراتيجية مع الاستيطان لفرض واقع جديد يهدف إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم وذاكرتهم. ويثير المقال تساؤلات حول دور المجتمع الدولي والمؤسسات الإعلامية في مواجهة هذا ‘الاستعمار اللغوي’، ويحث على ضرورة تبني الأسماء الفلسطينية الأصلية في الخطاب الإعلامي والرسمي كشكل من أشكال المقاومة والحفاظ على الهوية. كما يسلط الضوء على المسؤولية الملقاة على عاتق الفلسطينيين في توثيق هذه الأسماء وتعليمها للأجيال القادمة، لضمان عدم ضياع الذاكرة الجماعية.