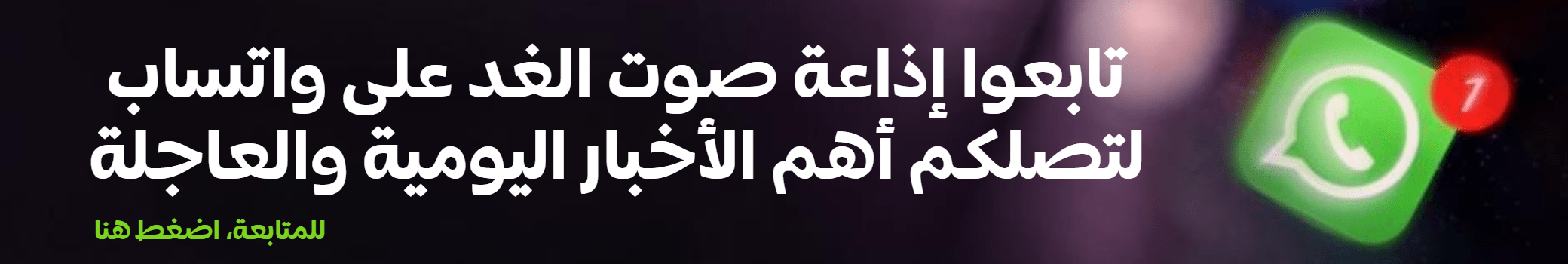يمثل الاعتراف طقساً كنسياً مسيحياً، وهو أحد ما عُرف بأسرار الكنيسة السبعة، غير أنه ومن وقت مبكر يمكن أن نقول إنه انسحب من مدلوله الديني الكنسي إلى مدلول أدبي مُغاير، فأصبح يُطلق على نوع من الكتابة السردية، يلتزم فيها الكاتب بسرد تفاصيل دقيقة وحرجة من حياته، أو حتى المواقف التي تصرّف فيها على غير ما تقتضيه الفضيلة والخُلق المستقيم، وقد أراد رواد هذا النوع من الكتابة السردية أن تكون الاعترافات بمثابة تقديم الإنسان لسيرته على حقيقتها من دون مواربة ولا تزويق.
وكان القديس أوغسطين (354م- 430م) أول من نقل مفهوم الاعتراف إلى عالم الكتابة السردية، فتناول في كتابه “الاعترافات” تفاصيل رحلته الروحية بين عدد من الأديان الوثنية، قبل أن يستقر على العقيدة المسيحية الكاثوليكية، غير أن هذا الكتاب لم يلقَ القبول والشهرة التي لقيها كتاب الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو (1712-1787)، والموسوم بـ”اعترافاتي”، وهو الكتاب الأشهر في هذا الباب، والذي دشن فعلياً هذا النمط من الكتابة السردية، حينما وضع في مقدمة كتابه الميثاق القرائي الذي استند إليه، إذ حدَّد هدفه بوضوح: “لقد صوّرت نفسي على حقيقتها، في ضعتها وزرايتها… وفي صلاحها وحصافة عقلها وسموها تبعاً للحال التي كنت فيها” (اعترافات روسو).
ومن ثم انطلق بعض رواد الأدب والسياسة والفكر الغربيون يدونون مذكراتهم بهذا النهج، متوخين الصدق والموضوعية، وكاشفين بجرأة ووضوح بعض خفايا شخصياتهم، وقضايا قد يتورع الإنسان العادي عن كشفها، ومن هذه المذكرات الاعترافية على سبيل المثال لا الحصر “اعترافات فتى العصر” لآلفريد دي موسيه، و”من الأعماق” لأوسكار وايلد، و”لو لم تمت المحبة ” لأندريه جيد.
أما على الصعيد العربي فلم يجد السرد الاعترافي ذلك الجذر الديني الذي يستند إليه كما هو الحال في النطاق الغربي، لكون مفهوم التوبة في الإسلام يأخذ منحى مختلفاً، إذ يجري بين العبد وربه بصورة ذاتية قلبية، ولا تتطلب الاعتراف بالخطأ عند رجل دين أو كاهن، وليس هذا فقط، بل قد أسهبت المدونات الحديثية الإسلامية في نقل وصايا النبي محمد ﷺ التي تحث على ستر ما يمكن أن يكون مثلبة لأحد ما، من منطلق أن الخطأ طبيعة إنسانية لا مناص منها، ومن هذه الأحاديث قوله: “مَن ستر مسلماً ستره اللهُ في الدنيا والآخرة”.
ولهذا حينما نطالع تراثنا العربي لا نقف على نصوص اعترافية مُتكاملة، وإن كُنا لا نعدم وجود نتفٍ وشذرات متفرقة في بعض الكتب كما في كلام أبي حيان التوحيدي في “الصداقة والصديق”، عن تعسر أحواله وسوء معيشته وجفاء أغلب أصحاب الشأن له، وكذلك ما جاء في كتابَي “المنقذ من الضلال” للإمام الغزالي، و”الاعتبار” لأسامة بن منقذ.

أمّا في العصر الحديث فلم تختلف أغلب كتابات السير الذاتية العربية عن النهج القديم، فتكررت لدينا السير المزوقة التي يَحرص كُتّابها على ستر المثالب وإشهار المناقب، ومن السير التي سبق وقرأتها في هذا المضمار كتاب “الأيام” لطه حسين، والذي استثمر فيه الأديب الكبير كل ما أوتي من أسلوب ذلق، وبيان ناصع في حَبك قصة مزوقة تُسرف في بيان ذكاء ومثابرة وكفاح صاحبها، دون أن تشي ولو على سبيل التلميح لمثلبة من مثالبه أو عيب من عيوبه، فالأيام أُعدت لتكون مَلحمة للأديب الضرير، ولا شك أن السياق فيهاـ سياق البطولة الاستثنائيةـ لا يسمح للبطل بكشف عيوبه!
على أنه بكل حال لا يمكن الركون لسيرة طه حسين في الأيام، ولا لكل سيرة أخرى بوصفها القصة الحقيقية والموثوقة للشخصية المحورية فيها، ومن جانب ثانٍ كان بعض الكُتّاب مدركين لمعضلة التصريح بحقيقة السيرة، وما تتضمنه من أسرار قد لا يجوز كشفها لاعتبارات اجتماعية ووظيفية شتى، ما حدا ببعضهم لصياغة ميثاق قرائي يتسم بالشفافية والوضوح، كالميثاق الذي صاغه غازي القصيبي، الوزير والشاعر السعودي، في مقدمة كتابه “حياة في الإدارة”؛ إذ تحدث عن أسرار لا يمكن كشفها وأسرار يمكن كشفها بعد توظيفها لاستخراج العِبر والدروس، وكأنه يقول من جانب ثانٍ إنه لن يقول كل الحقيقة، ولكنه لن يقول إلا الحقيقة، الحقيقة التي سمحت الظروف بنشرها، ومن هنا تبدو السيرة أكثر واقعية من حيث مضمونها وأفق توقع القارئ لما في جعبتها.
غير أن هذه المُحددات التي كانت تُقيد كُتّاب السير الذاتية العربية ستنجلي وعلى نحو استثنائي عند الكاتب والروائي المغربي محمد شكري (1935-2003)، الذي دوَّن سيرته الذاتية في رواية من جزئين: “الخبز الحافي” و”الشطار”، فمحمد شكري لم يكن يملك منصباً أو وجاهة معينة تجعله يتحفظ في سرد شيء من تفاصيل حياته القاتمة، ولم يكن له وضع أُسري مستقر يقف حاجزاً أمام كشف تفاصيل حياة الأُسرة المُفككة!

راح محمد شكري يعيد سرد مراحل حياته السابقة بكثير من الجرأة، ودون أي خجل أو تنكّر لها، فتحدّث عن أيام تشردُّه ونومه في الشوارع وعمله بالتهريب، ووصف بدقة ليالي السجن البائسة، فضلاً عن معاشرته الطويلة للمومسات، سرد هذه التفاصيل بطريقة تلقائية خالية من التكلف، بحيث لا يشعر القارئ أنه أمام كاتب يحاول رسم سياق سوداوي مُصطنع لحياته، ولا أمام شخصية تحاول تبرير مسار خاطئ مرت به، بل هو أمام شخصية وجدت نفسها منذ الولادة في وسط هذا الواقع، وعاينت منذ طفولتها قسوة الأب القاتل- قاتل الأخ الأكبر لمحمد شكري- والذي دفعها في النهاية للانزواء عن العائلة والبدء بمسار مختلف.
غير أن هذه التجارب القاسية والوقائع السوداوية التي أحاطت بمحمد شكري منذ بداياته قد خلقت منه شخصاً جُبل على الرفض، ومال إلى التحدي، تحدي الواقع، وتحدي المصير السوداوي الذي يُحيط به من كل جانب، ولذلك لم يكن غريباً أن يُقرر محمد شكري، وهو الشاب العشريني الأُمي أن يخطو تلك الخطوة الجريئة، التي تتمثل بمحاولة تعلمه القراءة والكتابة، وتدارُك ما فاته من تحصيل دراسي، ثم يقرر بعد ذلك بالجرأة ذاتها أن يصبح كاتباً، بعدما أدرك أن “الكتابة امتياز” لصحابها، حسب تعبيره، وانطلق بكتابه عدد من القصص القصيرة قبل أن يكتب سيرته الذاتية في رواية.
ومهما قيل في شأن هذه السيرة، وفي شأن صاحبها، فإنها تبقى نصاً أدبياً مهماً وثق حياة طبقة مُهمشة عاشت في فترة حرجة من التاريخ المغربي، وإن كانت دلالاتها أوسع، بوجود نسخ مماثلة من هذه الأوضاع في بلاد عربية أخرى، ولكنها لم تحظَ بمحمد شكري مماثل لكي يوثقها.
قصارى القول إن أدب الاعترافات العربي ظل مقيداً بمحددات دينية وسياسية واجتماعية، منعته من أن يبلغ شأن نظيره الغربي، وإن كان لا يخلو من تجارب اتسمت بالجرأة، وحاولت كسر هذه المُحددات كأوراق العمر للويس عوض، أو المثال البارز الذي غطَّى على ما سواه في هذا المضمار، أعني “الخبز الحافي” لمحمد شكري.