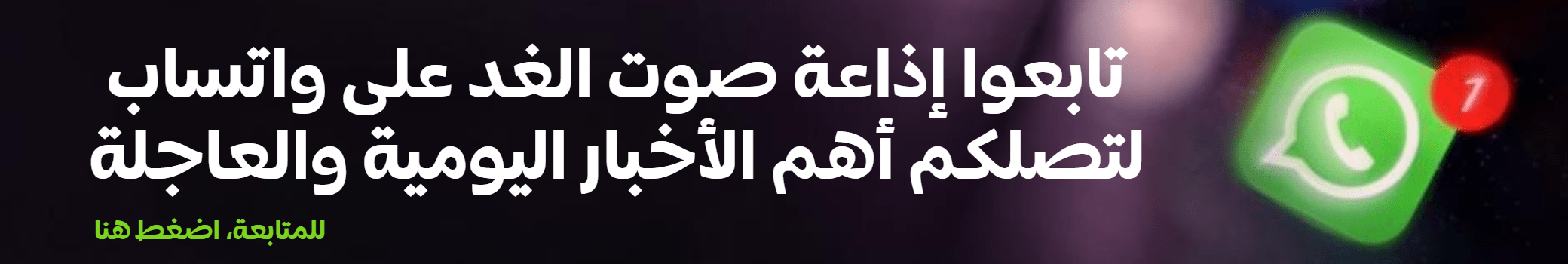يُعَد جوزيف مسعد أستاذ سياسة العرب الحديثة وتاريخ الأفكار في جامعة كولومبيا، من أهم المفكرين الذين اشتغلوا على تفكيك السرديات الاستشراقية والاستعمارية التي تغذي كلا من الفكر الغربي والصهيونية، وذلك طيلة العقدين الأخيرين، وذلك من خلال كتاباته الأكاديمية الرصينة التي سلطت الضوء على مدى أهمية القضية الفلسطينية، ومدى سعي الغرب والمشروع الاستيطاني الإسرائيلي لاستدامة الحرب على فلسطين والفلسطينيين، ومن بين هذه الكتب نجد “ديمومة المسألة الفلسطينية” و”التأثيرات الكولونيالية: صناعة الهوية الوطنية في الأردن” و”الإسلام في الليبرالية” و”اشتهاء العرب”.
وهو ما جعل من كتابات البروفيسور جوزيف مسعد تكتسي أهمية كبيرة، في ظل ما أعقب “طوفان الأقصى” أو ما بات يعرف بما بعد يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفق السرديات الغربية، التي عاشت فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي ومناصروها عبر العالم لحظات من اختلال التوازن وسقوط لسرديات القوة والهيمنة الاحتلالية التي كان يتم الترويج لها في السياق الغربي وصدقها العالم العربي.
تميزت كتابات المفكر جوزيف مسعد بكونها تحفر في جذور القضية الفلسطينية وتفكك المشروع الاستيطاني، وتسبر أغواره وتبحث عن الجذور الرابطة بينها وبين المشروع الاستعماري الكولونيالي الأوروبي الذي شهده العالم، وربط العلاقة العضوية بين الاستيطان الإسرائيلي والاحتلال الغربي.
لا يتوقف تفاعل البروفيسور جوزيف مسعد عند هذا الحد، بل سبر أغوار المقاومة الفلسطينية والدروس التي يجب أن نتعلمها منها، والتي يجبُ أن تتعلمها من حركة التاريخ التي شهدت مقاومات أخرى قاومت الاحتلال الأجنبي سواء في نجاحاتها أو إخفاقاتها، وحتى نفهم مواقفه أكثر نستضيف في الجزيرة نت البروفيسور جوزيف مسعد أستاذ السياسة العربية الحديثة في جامعة كولومبيا العريقة، فإلى الجزء الأول من الحوار:
رغم أن ما تشهده غزة طيلة هذه الأيام هو إجرام حقيقي تنتهك فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي كل الأعراف والقوانين الدولية، بارتكابها لـ”إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين، فإن هناك من يرى أن هناك “صيرورة تاريخية” تحكم المشهد بين المُستعمِر والمستعمَر تتكررُ عبر التاريخ، ومشهد غزة دليل على ذلك، هل تتفق مع هذا الرأي؟ ولماذا؟
نعم هذا صحيح، نحتاج دائما إلى التأكيد على أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يوضع في سياق التاريخ الاستعماري الاستيطاني لأوروبا والولايات المتحدة في العالم المستعمَر ككل، أي في الأميركيتين، وفي أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا وآسيا بالطبع.
أعتقد أن مجمل تاريخ الحركة الصهيونية وعنصريتها ونشاطها الاستيطاني منذ أوائل ثمانينيات القرن الـ19 إلى يومنا هذا هو جزء لا يتجزأ من الصيرورة والجهود الاستيطانية الأوروبية في بلاد “غير البيض”، وبالتالي لا بدّ لنا عندما نقدم تحليلا للتطورات التي تشهدها الساحتان الفلسطينية والإسرائيلية من النظر لهذه التطورات من زاوية المنظور التاريخي للاستعمار الأوروبي، والذي أصبح يعرف بـ”العالم الثالث”.
كما لا يخفى عليك هناك تصدير لخطاب “الشيطنة” للجانب الفلسطيني ككل من أجل خلق سردية تبرر “إبادة” الشعب الفلسطيني في غزة بدم بارد تحت أنظار العالم، كيف ظهر خطاب “الشيطنة” وما علاقته بثقافة الاحتلال والاستيطان؟ وكيف تحولت تهمة “معاداة السامية” إلى سلاح لحماية الصهيونية؟
أعتقد أن هذا الخطاب، قد بدأ مبكرا لا سيما أن بعض اليهود المستوطنين في فلسطين الذين قدموا من أوكرانيا وجنوب روسيا في أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر، كانوا قد عانوا من حركات مناهضة لليهود من قبل المسيحيين واللاساميين الأوروبيين، وعندما جاؤوا لاستيطان فلسطين، لم يكن لديهم فكرة بأن فعلهم الاستيطاني قد يولّدُ مقاومة ضدهم، لذا سعوا إلى شرعنة وجودهم الاستيطاني عبر ربط مقاومة الاستيطان بأنهُ رفضٌ لهم كيهود، لذا تشكل منذ ذلك الحين تياران داخل العقلية الصهيونية، أحدهما كان متَّسقا تماما مع نفسه في اعتقادي حينما أعلن بأن “كل من يواجه أي يهودي في العالم بغض النظر عن الأسباب فهو معاد للسامية”.
وقد تجدد هذا التيار بعد تأسيس الصهيونية في فلسطين أثناء الانتداب البريطاني في أواخر الحرب العالمية الأولى، لا سيما بعد غزو بريطانيا لفلسطين في أواخر 1917، ومن ثم نجد في العشرينيات أن كل مقاومة لتأسيس الاستيطان واستمرار الصهيونية في فلسطين رد عليها آنذاك صهاينة ذوو نزعات اشتراكية، بوصفها تستهدفهم كيهود، وتذكّرهم ببعض المذابح اللاسامية التي ارتكبت بحقهم في أوروبا.
منذ عشرينيات القرن الماضي تأسس خطاب يرى في المقاومة التي تقاوم الاستيطان الجاري في فلسطين شكلا من أشكال “معاداة السامية” عوضا عن النظر إليها باعتبارهِا حركة مقاومة للاستعمار، وهو ما شكل البروباغندا والدعاية السياسية الصهيونية، وهذا هو الخطاب الذي تبلور في ثلاثينيات القرن الـ20 مع صعود النازية في ألمانيا، واتخذ منحى أكثر جدية وصرامة من قبل الصهاينة، إذ أصروا على أن استيطانهم لفلسطين وعنفهم ضد الفلسطينيين ليس هو المحرك الحقيقي للمقاومة الفلسطينية، بل زعموا أن محرك المقاومة هو كره الفلسطينيين لليهود كيهود و”معاداة السامية” وليس كره الفلسطينيين للمستعمرين والمستوطنين.
استمر هذا النهج بعدما تأسست “المستعمرة الاستيطانية” المتمثلة في “إسرائيل” في عام 1948، لا سيما بـ”خطاب الدولة” الذي اعتبر رفض الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر التعاون والمساومة مع إسرائيل على أنه نابع من لاساميته، إلى حد اتهامه بالنازية في الخمسينيات قبل العدوان الثلاثي.
كما نجد بروز هذا الخطاب مجددا في النصف الثاني من ستينيات القرن الـ20 تجاه المقاومة الفلسطينية على أنّ هذه المقاومة تستهدفهم لكونهم يهودا لا باعتبارهم مستوطنين ومستعمرين لوطنهم. وفي أوائل السبعينيات قررت الحكومة الإسرائيلية أن تنتهج نهجا أكثر جدية وفعالية، أثناء انعقاد مؤتمر جمع بعض المنظمات اليهودية الأميركية في إسرائيل حيث أكد وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أبا إيبان (الذي يتحدر من أسرة استوطنت جنوب أفريقيا وكان اسمه الأصلي أوبري سولومون) على أن الإستراتيجية الجديدة للدعاية الإسرائيلية لمواجهة الاعتراض اليساري المنحى في الغرب على سياسات الاستيطان والاستعمار، حيث رأى أنهُ يجبُ أن يتم مساواة العداء للصهيونية بالعداء للسامية.
قرر أبا إيبان بأن ما يصدر من نقد من بعض القادة السياسيين في المجتمعات الغربية يجب النظر إليه بوصفه “لا سامية جديدة”، وعليه، تم اعتماد هذا النهج منذ أوائل السبعينيات من قبل إسرائيل من أجل وصم أي معارضة أو مقاومة لإسرائيل على أنها تنهلُ من نبع “معاداة السامية”، مما أدى بنا اليوم إلى تفاقم هذا الخطاب، لا سيما العقود الأربعة الماضية، كما أن الغرب قد بات شريكا لإسرائيل بعدما تم اعتماد هذا النهج من قبله كذلك عبر تعريف المقاومة العربية والفلسطينية للاستعمار والاستيطان الإسرائيلي على أنهُ ينبع من أصول “معادية للسامية” إن لم تكن “نازية”.
لكننا في المقابل لاحظنا منذ الخمسينيات وجود بعض النقاد الإسرائيليين لسياسات محددة للحكومة الإسرائيلية، حيث يصفون حكومتهم بأنها ترتكب أعمالا نازية، واستمر هذا في الخمسينيات لنجده يطرح مرة أخرى بعد “مجزرة صبرا وشاتيلا” عام 1982، وأثناء اجتياح إسرائيل للبنان في ظرف 4 سنوات (1978- 1982)، ولكن في المقابل وجدنا الجانب الفلسطيني والمتمثل على الأقل بـ”منظمة التحرير الفلسطينية” منذ أوائل السبعينيات إلى حدود أوائل الثمانينيات والتي تخللها خطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة عام 1974، تنتهج نهجا متضامنا مع كل اليهود من ضحايا اللاسامية والنازية.
قارنت “منظمة التحرير الفلسطينية” اضطهاد الفلسطينيين من قبل قوة استعمارية استيطانية، تتميزُ بانتهاج نهج قائم على الفصل العنصري والعرقي، بوضع اليهود أثناء المحرقة، وعليه كانت منظمة التحرير الفلسطينية تضعُ أكاليل الزهور في ذكرى المحرقة أو ذكرى انتفاضة حي اليهود في غيتو وارسو أثناء الحرب العالمية الثانية، تكريماً لليهود الذين عانوا من الفاشية كما يعاني اليوم الفلسطينيون من فاشية النظام الصهيوني حسب خطاب منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت.
إذن هنالك خطابان كلاهما ينددان بالآخر على أنه نازي وعنصري الهوى، لكن الفارق هنا هو أن الخطاب الإسرائيلي والصهيوني دائما ما يصم الشعب الفلسطيني ككل على أنه نازي، بينما الجانب الفلسطيني حريص على تركيز إدانته على النظام الإسرائيلي (والصهيونية) بوصفهما يحملان إيديولوجيا عرقية وفاشية ونازية، دون أن يربطها بشكلٍ حتمي بالشعب اليهودي، وذلك بالرغم من أن معظم استطلاعات الرأي منذ عملية “طوفان الأقصى” تظهر لنا بأنَّ أغلبية الإسرائيليين الساحقة أي ما يقدر بـ 98% ترى بأنَّ ما تقوم بهِ إسرائيل في غزة من قصف وقتل ليس كافيا.
تقدم إسرائيل نفسها للعالم على أنها من يدافع عن “فكر التنوير” و”الحضارة الغربية” من “بربرية” العرب والفلسطينيين، وتسوق إبادتها الجماعية في غزة على أنها حرب ” الخير ضد الشر”، هل هذا خطاب استعماري استيطاني كذلك؟
صحيح هذا الخطاب والنهج استعماري أوروبي قديم يعود تاريخه إلى القرن الـ19، حيث نجد أمثلة عديدة على استخدام المستوطنين المستعمرين الأوروبيين لخطاب مُمَاثل تماما خاصة حينما استخدمته بريطانيا لتبرير احتلالها لمصر حينما اعتبرت المقاومة على أنها همجية، وأنَّ بريطانيا ممثلة للحضارة وهو ما نجده كذلك في إصرار فرنسا على أن استعمارها للجزائر أو تونس هو جزء من الحملة الحضارية التي تقوم بها فرنسا في أراضي “الهمجيين” و”الوحوش”. ونجدُ أن هذا الطرح قد استخدم حينما احتلت أوروبا الأميركيتين في ما قبل عصر الأنوار وما بعد عصر النهضة، حيث تمت تسمية السكان الأصليين للأميركيتين بـ”الهنود الحمر” ووصفوا بـ”الهمجيين”؛ وبالتالي كان ينبغي قتلهم والإجهاز عليهم باسم الحضارة والمدنية الأوروبية.
الخطاب الصهيوني منذ بداياته يرى نفسهُ على أنهُ يقوم على الدفاع عن الحضارة الغربية، مثلا مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل في عام 1896 حينما نشر كتابه “دولة اليهود” (Der Judenstaat) أصرَّ على أنَّ الدولة اليهودية المزمع إقامتها في فلسطين ستكونُ حاجزا بين الحضارة الأوروبية والبربرية الآسيوية إن لم نقل أنهُ يقصدُ كذلك “البربرية العربية والإسلامية”، كما نجدُ “حاييم وايزمان” رئيس منظمة الصهيونية العالمية وأول رئيس لإسرائيل، يقولُ كلاما مشابها لما قالهُ هرتزل في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ20، على أنَّ الحركة الصهيونية تمثلُ “النور” فيما يمثلُ الفلسطينيون “الظلمات”، وعليه فإن ما نسمعهُ اليوم منذ بداية الهجوم الضاري على الشعب الفلسطيني في غزة ليس سوى استمرارية لنفس الخطاب الصهيوني الذي قمنا وضحنا جذوره.
يجبُ أن أنوهَ هنا إلى أنَّ الصهيونية ليست مبدعة في أفكارها، حيث اقترضت معظم أفكارها من الحركات الاستيطانية الأوروبية المسيحية، فمثلا الزعم بأنَّ اليهود الأوروبيين يريدون “العودة” إلى فلسطين التي تعدُ موطنهم باعتبارِ أنهم يتحدرون من العبرانيين القدماء، هذه الفكرة خيالية وخاطئة، وقد بات بعض العرب يظنُ أنها حقيقية دون وعي منهم بأنَّ يهود أوروبا اعتنقوا الدين اليهودي باعتبارهم أوروبيين ولم يكونوا مهاجرين عبرانيين من فلسطين إلى أوروبا، فهم لا يتحدرون من العبرانيين القدماء شأنهم شأن الأوروبيين المسيحيين الذين اعتنقوا المسيحية، ولم يأتوا من فلسطين حيث ترعرعت المسيحية كدين قبل اعتناق أوروبا لها.
كما أنَّ فرنسا أصرت بأن احتلالها للجزائر عام 1830 هو “عودة” الرومان إلى أراضيهم الرومانية، واعتبرت أنَّ العرب والأمازيغ هم المستوطنون الذين يجبُ طردهم من الجزائر، كما أنَّ الإيطاليين استخدموا الخطاب نفسه حينما احتلوا وارتكبوا جرائمهم ضد الشعب الليبي حينما بدأ الغزو الإيطالي لليبيا عام 1911؛ حيث أصَّرَ الإيطاليون على أنهم ورثة روما القديمة وبأنَّ ليبيا أرض رومانية يجبُ استردادها و”العودة” إليها وأن سكان ليبيا في ذلك الوقت ليسوا سوى مستوطنين للأرض الرومانية.
هذه المزاعم الأوروبية تنطبقُ تماما على الصهيونية التي مازلت تزعم بأن أصول اليهود تعود إلى فلسطين قبل ألفي عام، وبأنّ العرب والفلسطينيين هم المستوطنون لفلسطين، وهنا حتى لو قبلنا هذه المزاعم الكاذبة التي فندها المؤرخون وأكدوا زيفها، يجبُ أن نؤكد أن فلسطين لم يتم استيطانها من قبل العرب والمسلمين الفاتحين، بل، على العكس من ذلك، لم يأت أكثر من 4 آلاف عربي إلى فلسطين بعد الفتوحات الإسلامية، وكان معظم الموجودين في فلسطين من سكان فلسطين الأصليين الموجودين قبل الفتح الإسلامي، والذي اعتنقوا الإسلام بالتدريج عبر الزمن، وحجة الصهاينة في كون العرب المسيحيين والمسلمين ليسوا سوى مستوطنين هي فقط أكذوبة مفضوحة، ومجددا حتى لو افترضنا ذلك فهذا لا يشرعن للصهيونية القدوم بعد ألفي عام لتستبيح أرضا ليست بأرضها، وتطرد منها الفلسطينيين، وتسرق وطنهم منهم.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك فكرة تقول إن يهود أوروبا يمثلون الحضارة الأوروبية بخلاف السكان الأصليين الذين يمثلون الوحشية والبربرية والجهل الذي يمثلُ “الظلام” وعليه، فإن رفضهم لـ”التنوير” الذي يحملهُ الأوروبيون إليهم يبرر سياسة الاحتلال حسبَ منظورهم، وعليه نجد مجددا أن معظم المرتكزات الصهيونية تعتمد على نفس المرتكزات الاستيطانية والاستعمارية الأوروبية المسيحية التي أقرضت الصهاينة معظمَ هذه المفاهيم بما في ذلك أن الشعوب الأصلية لا تتمتعُ بـ”حق الدفاع عن نفسها” لأنها لا تعرفُ طريقها للحضارة، وعليه فإنها وفق زعمهم لا تمتلكُ أي “حق”، بالمعنى الحضاري والحداثي لكلمة “الحق” وبالأخص “الحق القانوني” كما يعرفهُ عصر ما بعد الأنوار في أوروبا، بينما يحق للمستعمِر “حق الغزو”؛ ووفق هذا “الحق” يحق للمستعمِر احتلال أي أرض لا سيما لو كان أهل هذه البلاد قد أخفقوا في تطويرها حضاريا حسبَ مزاعم الأطروحة الكولونيالية. وبالطبع ما تقوم به الحركة الصهيونية بمحو التاريخي الفلسطيني خاصة التاريخ الزراعي والتاريخ المهني هو تجسيد لأطروحة الكولونيالية.
وفق المنظور الذي شرحته والذي يربطُ الحركة الصهيونية بالإرث الاستعماري والاستيطاني في العالم، فهل يمكن اعتبار أن المقاومة في فلسطين بدورها استفادت من تاريخ حركات المقاومة وإرثها في مواجهة الاستعمار؟ أم أنها تبدع في مقاومتها بطريقة جديدة؟
تعتمد المقاومة في فلسطين في اعتقادي في مقاومة الاحتلال الاستيطاني على تاريخ وإرث المقاومة الشعبية في سواء في الجزائر أو تونس أو ليبيا أو المغرب، أو في جنوب أفريقيا، أو مقاومات الاستعمار الإمبريالي بعد الحرب العالمية الثانية كما حدث في فيتنام وكوريا، كما نهلت المقاومة الفلسطينية من تجارب المقاومة الفاشلة في الأميركتين وأستراليا ونيوزيلندا حينما تم الإجهاز على أغلب المقاومات الشعبية، رغم استمرارها الضعيف إلى الآن في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبت في حق الشعوب الأصلية في هذه المناطق.
كما أعتقد أن نهج الثورة الجزائرية يُعّدُ أقرَب نموذج ثوري قريبٍ للمقاومة في فلسطين، بسبب وجودِ تزامن بين احتلال فرنسا للجزائر والاستعمار الصهيوني والبريطاني لفلسطين على الأقل منذ عام 1917، وعليه فإن تزامن الاحتلالين لبعض الفترات جعل المقاومة الفلسطينية تستفيد من نظيرتها المغاربية.
أعتقد أن المقاومة الفلسطينية سواء في فترة الخمسينيات أو ما بعدها حينما تأسست الحركات الفلسطينية للتحرير، كانت المقاومة تنهل وتتعلم من تجارب حركات المقاومة التي تولدها الشعوب التي يتمُ احتلالُ أراضيها، وأعتقد أن من أهم الدروس التي استوعبتها أخيرا حركة المقاومة الفلسطينية التي تمثلها حركة حماس والجهاد الإسلامي وحركات المقاومة الأخرى، تتمثلَ في ضرورة أن يُجْبِرَ المُقاوِم قوى الاحتلال على محاربته وفق مقاييس المقاومة وأدواتها، وليس بحسب ما يقرره المستعمِر، بمعنى أنَّ المقاومة أدركت أنَّ الحرب بناء على معطيات المستعمِر تعدُ حربا خاسرة، لذا يجب على المُستَعْمَر خوض حروب أو معارك تَفرض على المُسْتَعمِر تبني إستراتيجيات لم تكن في حسبانهِ من قبل فتربكهُ وتسقطهُ في أخطاء إستراتيجية، ويمكنُ إدراج عملية “طوفان الأقصى” ضمن ذلك.
ولعل الهزيمة الأكثر شهرة من بين هزائم البريطانيين على يدِ قوات المقاومة هي تلك التي مُنوا بها في أواخر القرن الـ19 على يد جيش مملكة الزولو في معركة إيسانِدلْوانا بجنوب أفريقيا في يناير/كانون الثاني 1879، حيث استطاعَ جيش الزولو المكون من 20 ألف جندي مسلح بأسلحة خفيفة من هزيمة الجيش البريطاني المدجج بالأسلحة الثقيلة، ونتيجة خشية حكومة رئيس الوزراء البريطاني بنجامين دزرائيلي من أن انتصار الزولو سيشجع الشعوب المستعمَرة الأخرى عبر الإمبراطورية البريطانية على المقاومة، انطلق البريطانيون لإعادة غزو أرض الزولو في يوليو/تموز 1879 بقوة عسكرية أكبر حجما بكثير، قامت بنهب عاصمتهم أولوندي وهدمها وتسويتها بالأرض، كما قاموا بنفي ملك الزولو خارج البلاد، ولم يتردد البريطانيون عن قتل 10 آلاف من الزولو، رغم أن ذلك كلفهم فقدان 2500 جندي بريطاني.
نجدُ حدوثَ شيء مماثل باسم الدفاع عما يسمى بـ”الحضارة الغربية”، في عام 1965، قبل شهرين من إعلان المستوطنين البيض “استقلال” روديسيا، الذي عبّر عن نفسه من خلال ارتكاب مجازرٍ ضد السكان الأصليين على يد المستوطنين البيض.
وفي سياق مماثل، في عام 1896، قرر الإيطاليون، الذين كانوا قد أنشؤوا مستعمرة-استيطانية في إريتريا، من غزو إثيوبيا لاحتلال المزيد من الأراضي، لكنهم تعرضوا للإهانة والهزيمة على يد الجيش الإثيوبي بقيادة الإمبراطور الحبشي منليك الثاني. وقد قُتل الآلاف من الجنود الإثيوبيين والإريتريين والإيطاليين في “معركة أدوَة”، وهو ما عمّق إحساس إيطاليا بالذل أمام نظيراتها الأوروبية، إلا أنَّ انتقامها انتظرَ وصولَ النظام الفاشي للحكم؛ حيث انتقم موسوليني لإيطاليا من هزيمة “معركة أدوَة” عندما غزا إثيوبيا في عام 1935. وارتكب فيها مجازر قتل فيها 70 ألف إثيوبي لتتحول إثيوبيا إلى مستعمرة-استيطانية.
كما نجدُ ذلك في السودان أيضا حينما حرر جيش الزعيم السوداني محمد أحمد بن عبد الله، المعروف بالمهدي، الخرطوم من المستعمرين البريطانيين وهزم قواتهم في يناير/كانون الثاني 1885، لكن نتيجة القلق من الهزيمة التي مُنيت بها إيطاليا في أدوَة، قرر البريطانيون غزو السودان في عام 1896، واستولوا على الخرطوم في عام 1898 بعد أن قتلوا وجرحوا وأسروا أكثر من 30 ألف سوداني.
كما أن الفيتناميين الشماليين أذلوا فرنسا عام 1954 في معركة ديان بيان فو، مما دفع الأميركيين على الفور إلى الأخذ بزمام أمور الحرب، وقتلوا الملايين في العقدين التاليين في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، إلا أن الولايات المتحدة انهزمت كذلك في فيتنام وكمبوديا، ولكن بعدما قتلت 5 ملايين شخص في المنطقة.
إذن هناك أمثلة عديدة تظهرُ أن القوى الأوروبية شعرت بالإذلال والمهانة وخاصة أنها ترى نفسها “أرقى” و”أسمى” عرق وحضارة، بسبب هزيمتها من قبل عرق “أدنى” وفق علم الأعراق العنصري الذي أوجدتهُ أوروبا في القرن الـ19، وهذه التجارب كانت مهمة استفادت منها المقاومة الفلسطينية لجعل عملية “طوفان الأقصى” عملية مفاجئة للاحتلال الإسرائيلي، لأنَّ عنصريتهم وشعورهم بالـ”تفوق العرقي” لم يكن يتيح لهم تصور إمكانية أنَّ يقوم الفلسطينيون “الأقل منهم عرقيا” بحسب زعمهم العنصري بالمبادرة بالهجوم وبأن يلحقوا الهزيمة بالجيش الإسرائيلي، وأن يحتلوا قواعد عسكرية إسرائيلية، وأن يخرقوا جدار المعتقل الذي اسمهُ “غزة” الذي اعتقلتهم فيه الصهيونية ودولة إسرائيل لمدة 17 عاما. أراد نهج المقاومة أن يجبرَ إسرائيل على التعامل مع المقاومة الفلسطينية بحسب نهج المقاومة نفسها، وليس بحسب ما تفرضهُ إسرائيل على الفلسطينيين في الواقع المعاش.