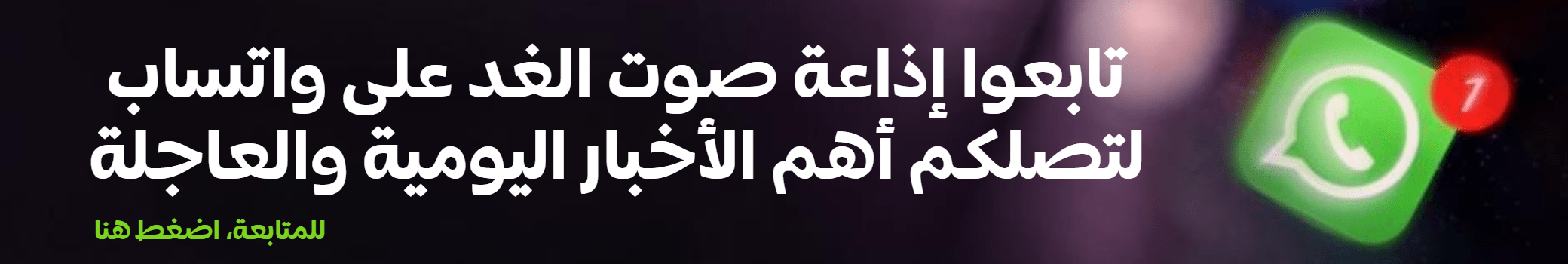بعد عقود من التحديث والعولمة التي شهدها العالم الإسلامي، ما زالت المنظومة الإسلامية صامدة بمنظومتها القيمية والأخلاقية تجاه المد الفرداني الذي تفرضه فلسفة الحداثة والعولمة عبر آليات النزعة الفردية والاستهلاكية، ورمضان محطة مهمة بالنسبة للمسلم ليس فقط للتقرب إلى الله بالعبادات والنوافل باعتباره “شهر القرآن”، ولكن كذلك باعتباره محطة لتهذيب النفس وتشذيب الروح.
ولأجل فهم آثار فلسفة الحداثة والعولمة والاستهلاك على عاداتنا وتديننا في رمضان، وكيف يمكنُ لـ”شهرِ القرآن” أن يكون درعا للمسلم تجاه المد الاستهلاكي المعولَم، تستضيفُ الجزيرة نت الأكاديمية الجزائرية الدكتورة نورة بوحناش أستاذة الفلسفة بجامعة قسنطينة 1 الجزائرية، والتي تشتغل عبر مؤلفاتها على كل من الدرس الفلسفي والدرس الأصولي والمقاصدي؛ حيث ألفت كتبا عديدة من بينها “الاجتهاد وجدل الحداثة” “مقاصد الشريعة عند الشاطبي” و”تأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي” و”الأخلاق والرهانات الإنسانية” و”إشكالية القيم في فلسفة برغسون” و”الأخلاق والحداثة”.
ووفق تصورِ بوحناش فإن العالم الإسلامي يشهد تغير مجموعة مهمة من القيم بفعل التدجين العولمي، وواقعُ رمضان أكد تكريس مجموعة من الممارسات الاستهلاكية المفرطة، حجبت النفسَ عن مهمة التهذيب والتشذيب باعتباره المقصد الأسمى لرمضان.
كما سلطت الضوء على خطر البرامج الدعوية الرمضانية التي انحرف مقصدها من كونها توجه الإنسان إلى تحولها لسلعة استهلاكية تتاجر بها الرأسمالية كما تتاجر بالأفلام والمسلسلات، وتذكر بوحناش، في حوارها للجزيرة، أن الأنموذج الحداثي غير متوافق مع الإسلام بسبب تعارضه مع مقاصده النهائية، لأن الإسلام مفارق للمادة ويجعل الجسد مخلصا لله، أما الحداثة فمقاصدها مادية وعليه فمن الصعب حسب بوحناش الحديث عن حداثة إسلامية قائمة على الحالية.
وإلى نص الحوار…
لكل عبادة فلسفتها، فما فلسفة الصيام حسب منظورك؟
لنتجاوز المزايدة الخطابية، ونعتمد الدربة المعيشة، ثم نستخبر بقايا الأخلاقية الإسلامية، شكلا أنثروبولوجيا بقي خافتا، في ثنايا النسق البنيوي للمجتمع الإسلامي، ليكونا شاهدين، على نجاعة الشريعة الإسلامية، إحاطة بكلية الإنسان قيادة له نحو الصلاح.
تعتمد الشريعة تبريرا منطقيا لمقاصدها اعتمادا على فلسفة التوحيد، ثم تتخذ أدواتها التشريعية مسلكا تربويا، يخترق كلية الإنسان تدريبا للجسد؛ توجيها صوب القيم، وتقويما للفعل في مدار سعيه نحو الصلاح.
تعتمد الشريعة تبريرا منطقيا لمقاصدها اعتمادا على فلسفة التوحيد، ثم تتخذ أدواتها التشريعية مسلكا تربويا، يخترق كلية الإنسان تدريبا للجسد؛ توجيها صوب القيم، وتقويما للفعل في مدار سعيه نحو الصلاح.
هي بالذات القيمة الإجرائية، التي تسري وفقها فلسفة الصوم، دربة بيولوجية، تربي الجسد على القيم، وهو بالذات الشيء الذي فشلت فيه الأخلاقية الغربية، في بحثها عن توازن بين النسبي والمطلق، بين الأخلاقي والحيوي، نظرا لافتقادها تقنيات أخلقة الذات.
تتبين الحكمة من العبادات المفروضة، والمعاملات المطلوبة، في تحكيم فوقي للقانون الأخلاقي ولادةً للخليفة المؤتمن، الإنسان الذي يعمل القرآنُ على تكليفه في سبيل الخلافة الكونية. لا يستأثر الصوم بهذه الفلسفة القرآنية.
خلاصة العبادات، تكمن في نيل الكمالات، التي تستوفي شرط النفخ الروحاني كتميز رباني حظي به الإنسان الخليفة. هي فلسفة القرآن التشريعية، المبينَّة في مقاصد العبادة، تتغيّا تهذيب النفس وتربيتها على الكمالات، والتحقق من القيادة الفوقية للأخلاق، باعتبارها ماهية الإنسان الأصلية، التي ترادف الحياة الطيبة.
فخلاصة العبادات، تكمن في نيل الكمالات، التي تستوفي شرط النفخ الروحاني كتميز رباني حظي به الإنسان الخليفة. هي فلسفة القرآن التشريعية، المبينَّة في مقاصد العبادة، تتغيّا تهذيب النفس وتربيتها على الكمالات، والتحقق من القيادة الفوقية للأخلاق، باعتبارها ماهية الإنسان الأصلية، التي ترادف الحياة الطيبة.

تطوع العبادة الجسد تهذيبا، وتبرهن على الصلة بين الجسد والروح. بالصوم يعرج الجسد إلى القيم يدركها ويمارسها، فيكون أسلوب تهذيب للطاقة الحيوية للبشر -تدريبا يتريَّض به الجسد على الصبر والأناة- وميزانا بين الأثرة والإيثار.
برهن العلم الراهن على مكمن الخير في الصيام، فعلى صعيد النظام الفيزيولوجي، يشكل الانقطاع عن الأكل، وسيلة علاجية وحياة للجسد. أما على صعيد التأصيل الأخلاقي المجتمعي، فالصيام ينشئ العلاقات الإنسانية التراحمية؛ بفعل الغيرية.
يهذب الصيام الغرائز ويثبت القيم، لتشعر الأنا بالتضحية والفقر إلى الله. كما تُحدث حكمة الصيام التوازن الذاتي، وتمنع الإنسان، من الوقوع في النمرودية والقارونية، بوصفهما مميزتَي الإنسان الحديث وما بعد الحديث، وصفتين للزمن المعولَم.
كيف يجب على المسلم التعامل مع رمضان، في ظل تمدد الممارسات الحداثية وما بعد الحداثية في واقعنا المعاصر؟
يعترف الدرس الكولونيالي (الاستعماري) بتفرد نوعي للهيمنة الإمبراطورية الغربية لم يجرِ نظيرها في التاريخ. لم يقتصر السلطان الغربي على التمدد الجيوسياسي الجغرافي، إنما تستوجب الظاهرة الرأسمالية الموصولة بالإمبريالية تسرب الهيمنة إلى الذات الإنسانية؛ بما يعني تربية الإنسان على الاستهلاك وبناء أنظمة نفسية ومجتمعية، تتحلق حول غاية وحيدة وهي تدوير الاستهلاك؛ فتعمل على ولادة المستهلك الذي انقطع عنه مدد الروح، ليغدو ترسا في الآلة الفردية لدورة الإنتاج الرأسمالي.
الأمر يجري على المسلم أيضا، فهل يتمكن الصوم من فك طوق الأنانية والهيدونية (اللذية) المهيمنة في زمن السيولة المفرطة؟ كيف يكون الصوم، قوة طردية تعيد تهذيب الذات على الوسطية؟ ما دور العبادة الإسلامية، في فك طوق العبودية الطوعية للنظام الاستهلاكي؟
يجب الاعتراف بأن الحداثة وما بعد الحداثة، يؤديان عملية هدم -تارة بطيئة وتارة متسارعة- للبنية الأنثروبولوجية، للمجتمع الإسلامي، الذي تشرّب الشريعة، وتغلغلت في بنياته منذ قرون، إذ تجري عليه عملية تفكيك نسقية، يعوض بها عادات أخلاقية مستتبة، بعادات استهلاكية طارئة، في سياق كوني يعلي من الإسراف ويجعله نمط حياة.

والحق أن الصوم التعبدي ينفي ظاهرة الإسراف بوصفها قيمة سلبية، ورذيلة لا يحبها الله. فقد فُرض الصوم ليحمي الإنسان من النهايات التي خلص إليها إنسان اليوم في جاهلية من جاهليات التاريخ. ففي سياقات التدجين العولمي غدا رمضان فضاء لممارسة الاستهلاك المفرط بسيولته العولمية؛ فبدلا من تهذيب النفس، ركن المسلم إلى عادات استهلاكية تقوض المقصد الأسمى لرمضان بوصفه زمنا روحانيا.
فهل يستطيع المسلم، أن يعيد مكتسبات الصوم كقيم محررة، تبعا للشهادة كنظام للحرية؟ تستوجب هذه الإعادة تفعيل طاقة النقد الذاتي، ونقد واقع الحداثة، وانفتاحا على الأنموذج الإسلامي انفتاحَ فكر وعمل، حينئذ سيعيد المسلم مميزات التخلق الرمضاني، الذي يقدم أنموذجا إنسانيا للبشرية المحصورة في عبودية الاستهلاك.
كيف تحول رمضان من شهرِ العبادة، إلى شهر الاستهلاك؟ وكيف لرمضان أن يرشّد عاداتنا الاستهلاكية؟
عطفا على ما سبق، لم يعد للصوم أثر على المسلم -بزمن التسارع العولمي المفرط- في تحصيل مقاصده التربوية والتهذيبية الرافعة نحو الصلاح. فقد غدت العبادة مجالا للتسوق وفضاء زالت منه الروح التي تبثها الشهادة في القلب.
انكمش على إثر ذلك وقْع رمضان على الروح فكان مجرد عادة، وطقسا، يتكرر بتكرار سنوات العمر لا أثر له على الروح؛ إذ تسبق القيم في الإسلام مطالب الجسد، في حين يعتبر غاية مركزية وقيمة استعمالية في النظام الحداثي الذي أُقْحِمَ فيه المسلم إقحاما، مفتقدا لأدوات التنهيض، التي ترشده نحو صلاح يحميه من تغول نظام العولمة.
الحق أن المتغيرات، التي حصلت في العالم الإسلامي، تحيلنا إلى قراءة متأنية، لظاهرة التدجين الرأسمالي، الذي خضعت له كل شعوب العالم، والنظر إلى طبيعة التحديث كبراديغم (نموذج) غربي يستولد العالم خدمة للنواة الإنتاجية.
كان الظرف الكولونيالي مرحلة مفصلية لفك سلطة الشريعة حسب وائل حلاق، أما ما بعد الكولونيالية فتعد مرحلة خطيرة من حيث تماهي الدولة القومية الحديثة في الفضاء العربي الإسلامي، مع الخطوات النسقية للحداثة الغربية، دون النظر إلى طبيعة هذه الخطوات المؤسسة على مرجعية تقوض الشهادة من أساسها ومن ثم أدواتها التعبدية.
من الجليِّ أن ما أدته الكولونيالية، لا يضاهي ما تؤديه الدولة الحديثة ما بعد الكولونيالية، من تدجين للإنسان على الأنموذج الغربي، في إطار وطني قومي، يرعى مرامي البراديغم الغربي، بوسيلة الثقافة الذاتية، فتم تطويع الدين لهذا المطلب، من خلال بيروقراطية تخدم المركزية الغربية، في مواقع إسلامية.
لذلك أصبح الصوم انقطاعا عن اللذة دون تهذيبها محدِثا تأجيجا لها. لا ننسى أن العولمة عبر أذرعها الإعلامية، أدت دورا خطيرا في إخراج الإنسان المسلم من سياقاته التعبدية، إلى اعتبار العبادة مجالا استهلاكيا.
الحاصل: تمكن عصر الحداثة وما بعد الحداثة من قلب العلاقة -بين القانون الأخلاقي والقانون الحيوي- التي تتكفل الشريعة بتنظيمهما بفوقية القانون الأخلاقي، بهذا عُكس الترتيب المنوط ببناء الإنسان المتعبد ليشهد الوجود الإسلامي اختلالا مركزيا في مقاصد العبادات جملة ومن ثم السياق التربوي والتهذيبي للصيام.
هناك حديث نبوي فاصل في أمر الحياة الروحية والجسدية للإنسان أثبته العلم المعاصر خبرة إجرائية “نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع”؛ بمعنى تهذيب الذات وترويضها على القناعة، خطةً تربوية تضطلع بها الأسرة، ثم الأمة إذا ما تبيَّنت أنموذجها المحرِّر وفتقت نير العبودية، الذي أوقعها فيه واقع الحداثة.
عموما كان على المسلم أن يقدم أنموذجه للإنسانية، بيد أنه امتثل الأنموذج الاستهلاكي، فبدَّل بالفضائل والكمالات المنوطة بالعبادة، رذائل الاستهلاك التي قلبت الحال، فغدا المسلم إنسانا ميِّتا كما هو حال الإنسان العابد لوثنَي الذات والمال. فهل يزيح نير العبودية العولمية ويعوضه بحرية العبودية لله؟ طاقة محررة من التزامات النظام الاستهلاكي العولمي.
هل أصبحنا نشهد نزعة استهلاكية دينية جديدة بفعل “البرامج الدعوية”، بدل التركيز على بناء علاقة مباشرة بالعبادات كالصيام والصلاة وغيرهما؟
يشهد عالم العولمة تضخما كونيا في سلطة السلطة، عبر الإعلام الذي يؤدي وظيفة خطيرة في تدجين الوعي الإنساني جملة على عبادة الفكرة التي تقود إلى الخضوع والهيمنة للأنموذج الاستهلاكي.
من جهة أخرى، يشهد مجال الدعوة في العالم الإسلامي فوضى مؤثرة بسبب البرامج الدعوية التي استحلت الفتوى توجيها للرأي العام الإسلامي، بل لها دورها في الانقسام الديني وتفريق الشباب إلى فرق تتصارع فيما بينها خدمة للسلط المتراتبة داخليا وخارجيا.
إذ لا تمكن الغفلة عن العلاقة بين البرامج الدعوية والخلفيات السياسية والأيديولوجية، التي تقود المنطقة العربية والإسلامية قيادة تستوفي شرط الغفلةِ عن كنه الإسلام الناهض وتثبيتِ العلم الزائف كدين يخدر الشعوب تبعا للمقولة الماركسية.
لا يستوعب الإسلام الإنشاء المؤسساتي للسلطة الدينية، ناهيك عن اتخاذ سلطة الإعلام مقاما لتوزيع الفكرة وتثبيتها مجالا للتصديق. في هذا السياق وقعت الكثير من البرامج الدعوية الرمضانية في منطق التوجيه والاستحواذ.
ويبدو خطر التوجيه في الدين عظيما، فالمؤمن يعتبر الداعية قائلا في مكان المشرع بعد غيابه، وهي نقطة خطيرة جدا أدت إلى تبعثر الموقف الديني واتخاذه شكل المنظر الإعلامي المؤثر كما هو في الأفلام والمسلسلات.
نسي الدعاة الإعلاميون أن الفتوى تقتضي الورع، وأن العالِم المسلم لم يكن يفتي إلا وقد حصل لديه رسوخ في التقوى والورع، وأن الكلام في الدين يقتضي الدراية بالقواعد الأصولية الاجتهادية.
لقد عجَّت الشاشات بالنجوم الدعاة الذين تضاربت سيرتهم مع مقاصد العمل الديني، وتحول الورع إلى منفعة والغاية من الوعظ إلى رياء.
والحق أن المواقف التي تميز الداعية فعلا واقعيا، هي التي تثبت قيمته، وعليه نجد قلة من هؤلاء الذين أحسنوا تقصي العلاقة بين العلم والعمل، وتمكنوا من قراءة مقاصد العبادات، وأثروا في المشاهد تأثيرا بالغا يحمله على التقوى والورع.
هل ابتعادنا عن ممارسات دينية مثل صلة الرحم والاهتمام بالجار كرّس الفردانية الحداثية وأسقطنا فيما تحدث عنه زيغمونت باومان بخصوص هشاشة الروابط الإنسانية في الزمن الحديث؟
لنستوعب المقدمات الواردة في الإجابات السابقة، نقول إن الليبرالية بوصفها ماهية للحداثة، تعتبر الإنسان قيمة استعمالية، وتعمل على حياكة العلاقات الإنسانية، انطلاقا من المنفعة لتكون علاقات حسابية، أضف إلى ذلك أن بنية المجتمع التعاقدي الذي ولدت على إثره الدولة الحديثة، يسبق الفرد فيها المجتمع، ويكون التئامه التئاما قانونيا وليس أخلاقيا.
أما المجتمع المفترض في الأنموذج الإسلامي، فيكون تعاقده تعاقدا ائتمانيا، تتساوى فيه الذوات، وتعقد علاقات تراحمية طبقا لفوقية القانون الأخلاقي الموصول بالميثاق الإلهي.
هذه الصورة التي تشرَّبها المجتمع الإسلامي، باتت تزول رويدا بفعل التدجين الحداثي للمجتمع، وفقا للصفقة النيوليبرالية (فلسفة اقتصادية تدعم رأسمالية السوق الحرة والحد من تدخل الدولة في الاقتصاد) التي تُجريها الدولة الوطنية ما بعد الكولونيالية مع النظام العالمي الذي رسمته العولمة.
هكذا تسربت الفردانية تدريجيا إلى الذات الإسلامية، وغدت وثَنا معبودا بدل الغيرية التي تكفّل بالعمل على زرعها الفضاء التراحمي بين الذوات، عبر تدابير الأوامر الشرعية: أحكاما واجبة وتطوعية أو إحسانا.
من الضروري الإقرار بأن المسار الذي يسلكه المجتمع الإسلامي، ينبئ بتفكك العلاقات وفقدانها القيم المزروعة في الجسد المجتمعي، يُرى ذلك في الأسرة التي استلهمت الأنموذج الغربي وسارت في دربه، تتبنى النمط الحداثي في أسرة نووية (غير ممتدة). لم تعد تجتمع الذوات إلا طبقا للقانون المدني مع تأثير ضئيل للميثاق الغليظ.
كيف يتمكّن رمضان من نقلِ الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر بلغة طه عبد الرحمن؟
فرضت العبادة في الإسلام من أجل أن تحيي الإنسان حياة الروح ليغدو إنسانا كوثرا، تتحقق لديه علامات الخلافة، باعتبارها أمانة القيم وحفظ الميثاق.
يؤكد فيلسوف الأخلاق نيكولاي هارتمان، أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يدمج الأكسيولوجيا (القيم) في الأنطولوجيا (الوجود)؛ بمعنى أن تكون القيم لديه واقعا متحققا وسفرا للجسد في فلك الروح ينتهي للصلاح في الدارين.
وفي استخبار طبيعة العبادات في الإسلام، نلمح إعجازها في القدرة العجيبة التي تتوسلها دمجا للأخلاق في الواقع، وذلك بإعلاء القانون الأخلاقي على القانون الحيوي، والصومُ يؤدي هذه العملية بوضوح.
فالتقوى تجعل الجسد مخلَصا لله، وفي إخلاصه ترتسم القيم سلوكا، وذلك هو النسق الأخلاقي لرمضان، بيد أن تحوله إلى شعيرة طقسية أفقده القدرة على إحياء الإنسان، لذلك صار المسلم إنسانا ميتا أبتر، يبيع ويشتري قيمه في فضاء التسوق العولمي.
إذا كانت البروتستانتية وراء روح الرأسمالية حسبَ ماكس فيبر، فما الذي يؤسسُ له الإسلام هل لقيم دينية وروحية تنتمي لروح العصر؟
العلاقة بين الإسلام والحداثة علاقة قلقة. فهل يمكن أن يكون الإسلام حداثيا وفقا للبراديغم (للنموذج) الغربي؟ الحقيقة أن الإجابة تكون سلبية فالأوليات مختلفة والمقدمات متباينة، فنحن إزاء أنموذجين لا يلتئمان ألبتة؛ ففي الإسلام لن يكون المال دُولة بين الأغنياء.
المقصد الأسمى للعمل الاقتصادي في الإسلام يتمثل في نشر الخير المادي، بوصفه وسيلة فقط وليس غاية، مما يعني أن الفاعل سيتنازل عن المنفعة والربح باعتباره غاية أخيرة، بل الغاية من جمع الثروة هي تعميم الخيرات في الأرض ومكافحة الفقر. ويحمل التاريخ الإسلامي صورا عن شخصيات أعلت الصلاح على المصالح المادية، ولم ينتشر الإسلام في آسيا إلا بالسيرة الأخلاقية.
القيم الأخلاقية قيم مشتركة بين البشر، لا يعلو فيها الحاكم على المحكوم، ويرحم بها الأغنياء الفقراء، وتعتمد الرؤية الإسلامية على تنمية الأخوة والرحمة بين الناس، بأدوات إجرائية، تجعل من الثروة مثلا أمانة يتحملها المكلف.
فالزكاة هي النماء والبركة، أما الصدقة فعلامة على محبة الإنسان لله ومحبة الله له، إنها تقتلع الأنانية (الشح والبخل)، جاعلة الكرم من القيم التي يتسم بها الأفراد، لتعم كل المجتمع، وسمة للتعالي الإنساني، فيشعر الإنسان تجاه أخيه بالمسؤولية والرحمة.
الحاصل أن الإسلام يرتكز في عمله التربوي للإنسان على تقنيات تتسرب إلى الذات في وصال تتزن فيه العلاقة بين الروح والجسد، ويوسع الرؤية إلى الوجود، بالتوحيد الذي يعني الزمن الممتد حيث تنتفي الموت وتزول العدمية، من هذا الباب يشكل الإسلام أنموذج الصلاح الإنساني الذي يحول دون استتباب الجاهليات.
أما الجمود على التقليد فهو ظاهرة تؤول إلى الانحطاط الحضاري للأمة. ونذكر بقصور النخب في العالم الإسلامي، وانقسامها بين تقليد السلف وتقليد الحداثة الغربية.
ويعد مالك بن نبي مفكرا إسلاميا تمكن من السير في درب ثالث؛ حيث قرأ الإسلام قراءة تخطت التقليد وفتحت أفق النهضة الإسلامية.