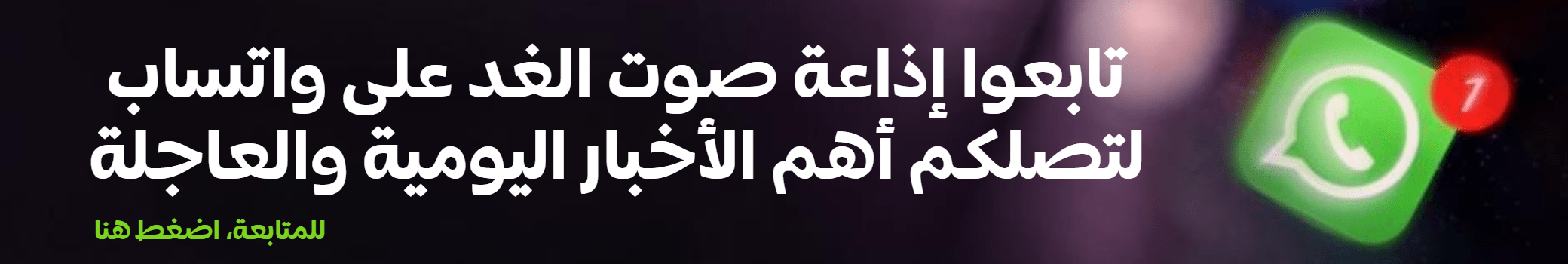عن 100 سنة، رحل وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، مفلتاً من أدنى عقاب. هنري كيسنجر الذي يتم وصفه اليوم في كثير من وسائل الإعلام، لا سيما في الغرب، تارة “بالعملاق”، وأحيانًا بـ”بالساحر”، ربما يستحق بالأحرى وصف “وحش” الدبلوماسية الأمريكية.
سجل حافل بخروقات القانون الدولي
في كتابه “محاكمة هنري كيسنجر” الصادر سنة 2001، يستند الصحفي البريطاني كريستوفر هيتشنز إلى وثائق رسمية أمريكية، رفعت السرية عنها، كي يعرض تصرفات كيسنجر التي يمكن أن تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
حافل هو سجل كيسنجر في انتهاكات القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهو لا يبدأ من الإطالة غير المبررة لأمد حرب فيتنام وجعلها تمتد إلى كمبوديا ولاوس، مروراً بحملات الاغتيال وتقويض الديمقراطية في تشيلي وقبرص واليونان وبنغلادش، ولا ينتهي بتواطئه في الإبادة الجماعية في تيمور الشرقية. ولا ننسى، من جهة أخرى، توفير كيسنجر الدعم الكبير للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وشعوب عربية أخرى، هذا بالإضافة -ولو كان ربما الدليل الحسي على ذلك ما زالت دونه عقبات معينة- إلى المخططات التي تنسب للدبلوماسي الأمريكي من أصل ألماني في محاولاته تغيير خارطة الديمغرافيا في الشرق الأوسط لإيجاد حل للقضية الفلسطينية بما يلائم إسرائيل، وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني وشعوب عربية أخرى، وما نتج عنه من حروب أهلية أيضاً (لبنان مثالاً).
توفي كيسنجر دون أن يحاكم على أي من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، ولعله لم يشعر بالقلق الحقيقي إلا في باريس، عندما سلمته المفرزة الجنائية، في 28 مايو/أيار 2001، بمناسبة مروره في العاصمة الفرنسية، استدعاءً من القاضي روجيه لو لوار، للمثول كشاهد في قضية اختفاء خمسة فرنسيين في تشيلي في عهد صديقه وحليفه بينوشيه، فكيسنجر كان قد شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في وضع خطة “كوندور” للقضاء على المعارضين في 6 دكتاتوريات عسكرية في أمريكا اللاتينية، ومن ضمنها تشيلي. في اليوم التالي للزيارة التي أجرتها له المفرزة الجنائية، غادر كيسنجر فرنسا على عجل.
يشكل مثال كيسنجر نموذجاً صارخاً لإفلات القادة الغربيين من العقاب بفعل انتهاكهم للقانون الدولي، وذلك في قضايا تحصل غالباً خارج الغرب.
في أحد كتبه بعنوان “هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين” يؤكد كيسنجر، بما لا يخلو من الكثير من العجرفة والتناقض، أن الخطاب حول حقوق الإنسان، الذي يدّعي أبوّته، يجب أن “يخدم قبل كل شيء كسلاح دبلوماسي يتم توفيره لمواطني الدول الشيوعية لمحاربة النظام السوفييتي، وليس سلاحاً قانونياً يمكن استخدامه ضد القادة السياسيين أمام محاكم دول ثالثة” (مبدأ الولاية القضائية العالمية)، قبل أن يضيف أنه من الضروري حظر “استخدام مبادئ القانون لأغراض سياسية”.
ويندرج ضمن سياسة الإفلات من العقاب هذه رفض الولايات المتحدة، وكذلك إسرائيل، الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى تهديد الولايات المتحدة، على لسان دبلوماسي أمريكي آخر هو جون بولتون، في سبتمبر/أيلول 2018، بعقوبات ضد هذه المحكمة الدولية في حال تجرأت الأخيرة على محاكمة مواطنين أمريكيين، لا سيما في الملف الأفعاني منذ 2001.
بعكس ما يقوله كيسنجر في كتابه، من البديهي القول إنه من الواجب أن يكون القانون الدولي، وما يكفله من حقوق للدول وللأفراد، سلاحاً قانونياً يمكن استخدامه ضد القادة السياسيين، أمام المحاكم الوطنية و/أو الدولية. وفي الواقع، إنّ عدم إمكانية استخدام هذه الحقوق بفعالية أمام المحاكم -إذ إنّ إرادة الدول تسمح لها بالتهرب من اختصاص المحاكم، وخاصة الدولية منها، مثل المحكمة الجنائية الدولية-، مع ما يرافق ذلك من عدم تمكّن المحاكم الدولية من القيام بالمهمة التي أنشئت من أجلها، غالباً ما يشكل السبب الذي يدفع ممثلي المتقاضين، كنتيجة لعدم الفاعلية القانونية هذه، إلى الاكتفاء بتسييس مقابل للقضاء الدولي، لا سيما عن طريق الاستثمار السياسي في هذا القضاء عبر تحويله إلى مجرد أداة للدعاية والضغط السياسيين والثقافيين، مقزمين بذلك دور المحكمة الجنائية الدولية ومحوِّرين جوهر مهمتها، ألا وهي محاكمة المتهمين بناءً على القانون الدولي الجنائي. وهذا ما يدأب عليه حالياً كثير من الذين يبنون الآمال على محاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين في الحرب الجارية ضد غزة.
الحرب ضد غزة والإفلات من العقاب
لبّ المشكلة في أنّ التطبيق القضائي للقانون الدولي الإنساني غالباً ما يكون من قبل محاكم دولية تنشأ أصلاً بناءً على إرادة الدول (قرارات مجلس الأمن، أو معاهدات دولية كنظام روما الأساسي)، وغالباً -كالجنائية الدولية- لا صلاحية لها إلا على مواطني الدول التي تقبل بصلاحية المحكمة، فموافقة الدولة (أو إلزامها بقرار من مجلس الأمن) على اختصاص محكمة دولية، شرط ضروري لتكون هذه المحكمة نافذة بالنسبة لهذه الدولة. بكلام آخر، صلاحية المحاكم الدولية رهينة الإرادة السيادية السياسية للدول، وفي هذا لا تشذ المحاكم الدولية عن طبيعة القانون الدولي التي تنشأ هذه المحاكم على أساس قواعده، إذ إنّ أساس الطبيعة الإلزامية للقانون الدولي -ما عدا القواعد الآمرة jus cogensـ، وبعكس القانون الداخلي بما خص الأفراد، هو إرادة (أو قبول) الدول.
هنا، القانوني لا يمكن فصله عن السياسي، لأنّ السياسي ينشئ القانوني، والقانوني هو رهن الإرادة السياسية للدول: مساراً ومادة وتطبيقاً. تداخل السياسي بالقانوني يدفع كثيراً من الأوساط الحقوقية إلى طرح علامات استفهام حول أداء المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما إلى انتقاد انتقائية هذه المحكمة في تحقيقاتها وعملها، إذ لا تهتم عملياً إلا بملاحقة المتهمين من دول أفريقيا والعالم والثالث، أو الدول المعادية للغرب، في حين أنّ الدول الغربية “مرتاحة” من تحقيقات المحكمة الجدية رغم أن هذه الدول هي غالباً أكثر دول تشن الحروب في العالم.
ونظراً لواقع أنّ إسرائيل لم تصدق على نظام روما الأساسي (رغم أنها قامت بتقديم تحفظات عليه عند توقيعه سابقاً) الذي ينشئ الجنائية الدولية، وأنها الطفل المدلل لدى الدول الغربية لا سيما الثلاثة منها دائمة العضوية في مجلس الأمن، فطريق العدالة في هذه الحالة ليس فقط صعباً، بل شبه مستحيل عملياً.
أما القول إنّ السلطة الفلسطينية عضو في الجنائية الدولية، فغير كافٍ لتبديد المخاوف وتذليل العقبات المذكورة آنفاً، وذلك أقله لسببين: أولاً لأنّ إسرائيل لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ولا باختصاصها (صلاحيتها)، فالمحكمة بحكم غير الموجودة بالنسبة لدولة إسرائيل، ولا قيمة قانونية لعمل المحكمة لا سيما فيما يتعلق بإسرائيل، فعمل المحكمة غير نافذ (non opposable) بالنسبة لهذه الدولة. ويعني ذلك عملياً أنّ إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة لا في التحقيق (لن تسمح لمحققي المحكمة بالدخول لإسرائيل أو للأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بعملهم)، ولا في تنفيذ الأحكام إن صدرت، ومن المستبعد واقعياً أنّ تتعاون أية دولة غربية مع الجنائية الدولية لتنفيذ أحكامها بحق مواطنين إسرائيليين مدانين ممكن أن يوجدوا على أراضيها، هذا في حال صدرت هكذا أحكام، والنتيجة هي فعالية قانونية إجرائية شبه صفرية.
أما السبب الثاني، فهو أنّ الأداء العملي لهذه المحكمة في الملف الفلسطيني غير مشجع، فالتحقيق لم يتقدم منذ سنوات، وهو أمر مشابه لأدائها في ملف أفغانستان (لا سيما بوجه أمريكا)، وذلك على عكس أدائها في ملف الاحتلال الروسي لأوكرانيا مثلاً، حيث تم تسطير مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بظرف شهور من بدء حربه على أوكرانيا.
أمام هذا الواقع القانوني شبه المقفل، يلجأ كثير من ممثلي المتقاضين أمام الجنائية الدولية إلى الاستثمار السياسي المقابل فيها، بحيث يكتفون بأن يكون التحرك أمام المحكمة الجنائية الدولية مجرد هجوم سياسي إعلامي على إسرائيل، من باب أنّ الأخيرة ترفض اختصاص هذه المحكمة ونددت بها، في حين أنّ السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المسلحة تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في محاولة إظهار أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية، وأنها ليست دولة قانون، لأنها ترفض القوانين الدولية.
ولكن من الجدير التأكيد على أنه لا تقاس جدية أي مسار قضائي بقدرته على تحويل محكمة معينة إلى شركة علاقات عامة بهدف الضغط السياسي، أو إلى جمعية غير حكومية تناضل من أجل الحريات بوجه أنظمة قمعية، بل تقاس جديته حصراً بمحاكمة المتهمين وبقدرته على محاكمة المتهمين. ليس دور القضاء أن يعيد التذكير بالجرائم المرتكبة، أو أن يضع الضغط من جديد على نظام مجرم يحاول الإفلات من العقاب وإعادة تبييض صورته، أو التوثيق القضائي، كما يقول كثير ممن يبنون الآمال الكبيرة على الجنائية الدولية في ملف غزة. هذه الأمور مهمة جداً، ومشروعة، وقيمة، لا سيما بوجه البروباغندا الإسرائيلية، ولكن هذا عمل دعاية سياسية وإعلام، وليس عملاً قانونياً، وهي أمور ليست من اختصاص القضاء، وليست من دوره. القضاء ليس نصباً تذكارياً أو جمعية إحياء ذاكرة، وليس لوبي ضغط سياسي أو ثقافي، وليس مركز توثيق وأرشيف، وليس وسيلة بروباغندا أو دعاية سياسية أو إعلامية.
تتعقد الأمور خصوصاً عندما يتم الاكتفاء بهذه الأبعاد السياسية الثقافية كبديل عن البعد القضائي المحض لمسار هو بأساسه وبجوهره قضائي، بحيث يصبح الرديف أهم من الأساسي وبديلاً عنه، يتم عملياً الاكتفاء به، بحيث يصبح تسخير التقاضي لأهداف سياسية ثقافية، وفي ذلك عدم احترام لمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، ناهيك عن تقزيم للقضاء ودوره.
الخروج من لعبة الخداع المتقابل
هل هذا يعني أنه يجب التخلي حكماً عن المسار القضائي أمام الجنائية الدولية فيما خص الحرب ضد غزة؟ طبعا لاً. ولكن هذا يعني أنه يجب قول الحقيقة للفلسطينيين كما هي، لأنهم أكثر من يستحقها، وعدم الترويج لآمال واهية هي أقرب للأوهام في هذا الخصوص، وخصوصاً عدم الظن أنّ المسار القضائي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين ممكن أن يشكل حلاً جدياً أو أولوياً لمعاناة الشعب الفلسطيني ولاسترداد حقوقه، أو استراتيجية تصلح أن تكون بديلة عن الاستراتيجية الحقيقية لاسترجاع الحقوق (العمل المقاوم والعمل السياسي)، وعدم التعويل عليه في ذلك.
أما الأهمّ، فهو أنّ المفارقة تكمن في أن مشاركة ممثلي المتقاضين في لعبة الخداع والاستغباء السياسي المتقابل هذه أمام بعض المحاكم الدولية، وذلك استعاضة عن العمل القانوني البحت بسبب تعثره أمام هذه المحاكم، تخدم عملياً، ولو بطريقة غير مباشرة، سياسة الإفلات من العقاب، لا سيما أنها لعبة خداع تتيح بالمقابل، لقوى كبرى في العالم، لا سيما في الغرب، إمكانية التستر، بنفاق كبير، وراء وجود هكذا محاكم كي تعطي نفسها صورة جميلة في نشر مبادئ احترام القانون وحقوق الإنسان، في حين أنها تعلم علم اليقين أنّ هذه المحاكم لن تؤدي إلى أية نتيجة عملية دون إرادة الدول، كما تم تبيانه أعلاه.
غادر كيسنجر مفلتاً من العقاب، ولكن يبقى إرثه الفكري الأساسي هو الواقعية التي دفعته مثلاً، في بداية مسيرته، إلى كتابة أطروحته عن مترنيخ، المستشار النمساوي. والمفارقة أيضاً في أنه إن اعتمدنا واقعية كيسنجر، يمكننا، من جهة أولى، أن نرى أن القانون الدولي هو في الأساس طوعي (أي إلزاميته خاضعة لإرادة الدول)، وذلك كي نتمكن من الخروج من لعبة الخداع المتقابل المذكورة أعلاه، والتي سمحت لشخص مثل كيسنجر نفسه بالإفلات التام من العقاب، ومن جهة ثانية، كي نفكر، بناءً على هذا الواقع، في سبل جعل القانون الدولي أكثر فعالية.